العدالة والتنمية الاجتماعية في القرآن

العدالة من المبادئ الإنسانية العريقة التي يمتد وجودها إلى قِدَم عمر البشرية، فمنذ الفجر الأول للتاريخ وبداية الخلقة عرفتها البشرية بوصفها حاجة متأصلة في أعماق الوجود الإنساني فقبلتها وأذعنت لها وجعلتها اللبنة الأساسية لقوانينها وقضائها. وليس هناك من شيء أشد وقعاً على الفطرة البشرية وإثارة لنفرتها وكراهيتها، كهضم الحقوق التي يعاني منه الضعفاء والمظلومون، وليس هناك ما يخلّف العداوة والبغضاء في القلوب أشدّ من الظلم ومناوأة العدل.إنّ افتقار المجتمع للعدالة كان -على الدوام- السبب الذي أدى إلى وقوع أغلب الثورات، ولذلك تزعّم جميع مصلحي التاريخ وقادة التحرر حركاتهم الإصلاحية مستهدفين إقامة العدل والقسط، والقضاء على كافة أشكال التمييز والظلم.فتلقت الأُمم والشعوب تلك الدعوات الإصلاحية بكامل الرضا والقبول، فقد كانت متعطشة للعدالة مؤتمرة بأوامر أُولئك المصلحين، متطلعة لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل الذي هو ضالة الفطرة السليمة.والأهم من كل ذلك أنّ العدالة تمثّل هدفاً دينياً ربانياً كان يشكّل محور رسالات الأنبياء، الذين ضحوا بالغالي والنفيس ولم يبخلوا بأرواحهم في سبيل تحقّق العدالة ونشرها بين أوساط الأُمة. وعليه فإنّ هذه المقولة تتطلب قدراً من التأمل، لاسيما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية من وجهة نظر القرآن، والتي سنتناولها هنا بالدراسة والتحليل بقدر ما يسمح به البحث. مفهوم العدالة:لقد صرّح اللّغويون بشأن «العدل» على أَنّه يعني المساواة والتكافؤ. وقالوا بأنّ «العَدل» و«العِدل» مفردتان مترادفتان في المعنى، غير أنّ «العَدل» يختص بالأشياء التي يدرك تساويها بالبصيرة، في حين يستعمل «العِدل» في مجال تلك الأمور التي يدرك تساويها عن طريق الحس. والعَدل هو المساواة في الجزاء، والإحسان مضاعفة الثواب[1]. قال ابن فارس: العين والدال واللام أصلان صحيحان، لكنهما متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواء، والآخر يدلّ على اعوجاج. والتعبير الأوّل: العَدْل من الناس، أَي الشخص ذو النهج المستقيم المرضي عند الناس المستوي الطريقة، يقال هذا عَدلٌ، وجمعه «عدول». والعَدِل الحكم بالاستواء، والعَدل: نقيض الظلم والجور. التعبير الثاني: بمعنى الاعوجاج والانحراف، عَدَل، وانعدلَ، أي انفرج[2]. كقوله تعالى: ?ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَّهِمْ يَعْدِلُونَ?[3].والعدالة في الشريعة تمثّل الاستقامة على الحق وغلبة العقل للهوى، أمّا العدالة عند الفقهاء فهي اجتناب كبائر الذنوب وعدم الإصرار على صغائرها ورعاية التقوى وملازمتها وترك المحرمات وفعل الواجبات، والابتعاد عن الأفعال الوضعية، ويصطلحون على ذلك بملكة العدالة[4].أمّا المفكرون والحكماء والفلاسفة فلهم تعاريف مختلفة للعدالة، وهذا ناشئ من اختلاف الظروف التي كانت تسود المجتمعات والتي تحكم ذهنيات الأفراد. فقد كان للفلاسفة والحكماء إبان القرون الوسطى -مثلاً- عناية وأهمية فائقة بالطبيعة وتأثيرها على الأفراد والحكومات، الأمر الذي جعلهم يذهبون إلى أنّ العدالة تمثل السلوك الذي ينسجم والطبيعة ورعاية الحقوق الطبيعية.فيرى هؤلاء الفلاسفة أنّ العدالة عبارة عن مبدأ مثالي، أو طبيعي، أو توافقي يتكفّل بتعيين الحق، ويوجب الإقرار به ورعايته عمليًّا[5].ولذلك يعتقد أرسطو بأنّ العدالة بمعناها العام إنّما تشمل جميع الفضائل، أمّا بمعناها الخاص، فهي فضيلة يتحتم بموجبها إعطاء كل فرد حقه. ثم أضاف الحقوقي الرومي «سيشرون» هذه العبارة- لذلك التعريف- وهي: «شريطة ألاّ تضرّ بالمصالح العامّة».وقد عدّ الحقوقيون وحكماء الغرب تعريف أَرسطو مع عبارة سيشرون المكملة له من أنجح التعاريف التي ساقها الفلاسفة حول مفهوم العدالة[6].أفلاطون بدوره يرى أنّ العدالة وشيجة تؤدّي لالتحام أفراد المجتمع أو وحدتهم من أجل الانسجام والتنسيق[7].وقد أُضيف لمعنى العدالة في عصر النهضة: «ضمان مصالح الآخرين، وقيل بأنّ العدالة الاجتماعية تعني احترام حقوق الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه»[8].وقد وردت مثل هذه التعاريف في كلمات العلماء والمفكرين الإسلاميين أيضاً.فقد عرّفها الطبرسي بأنّها تعني مماثلة الشيء لنفسه، أي المساواة، فقال: «هو[العدل] مثل الشيء من جنسه...»[9].أمّا ابن أبي الحديد فهو يعتقد بأنّ العدالة خلق متوسط بين الإفراط والتفريط فيقول: «العدالة هي الخلق المتوسط، وهو محمود بين مذمومين، فالشجاعة محفوفة بالتهور والجبن، والجود بالشح والتبذير... وعلى هذا كل ضدين من الأخلاق فبينهما خلق متوسط، وهو المسمى بالعدالة...»[10].وصرح الشيخ الأنصاري بأنّ العدالة تعني الثبات والاستقامة[11]، وذكرها العلاّمة الطباطبائي قائلاً: «العدالة هي المساواة والموازنة بين الأُمور بحيث يحصل كل على استحقاقه»[12].وقال في موضع آخر: «العدالة هي الحالة الوسطى بين الإفراط والتفريط»[13].الشهيد المطهري عرفها قائلاً: «العدالة تعني إعطاء حق كل ذي حق وعدم الاعتداء على حقه»[14].طبعاً فصل الخطاب -والأهم من كل ما ذكر- قول الإمام علي (عليه السلام) بأنّ العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. فيقول (عليه السلام): «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه»[15].ثم وصفها في موضع آخر بأنها الإنصاف والاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط، و«وضع الأشياء مواضعها»[16].العدالة الاجتماعية، هدف البشرية على مدى التأريخ:منذ بزوغ فجر الخليقة والبشرية تئن من سياط الظلم والجور، وتتطلّع للعالم الذي لا يسوده التمييز والتجاوز والاعتداء. وقد تطلّعت البشرية على مدى التاريخ بكافّة أفرادها وطبقاتها ومجتمعاتها، صغيرها وكبيرها، مؤمنها وفاسقها، رجالها ونساؤها، حتى ظالمها ومظلو مها، عالمها وجاهلها لإقامة العدالة وتطبيقها بين الناس، فهي صفة إنسانية قد استبطنتها فطرة الإنسان التي تأبى رفضها والتمرد عليها.أضف إلى ذلك، فإنّ الصورة التي رسمها كافّة الحكماء والفلاسفة للمدينة الفاضلة كانت قائمة على أساس التكافؤ والمساواة، إلى جانب تطبيق العدالة الاجتماعية، التي تعدّ الركن الركين لتلك المدينة. وسنعرض هنا لآراء بعض الحكماء بهذا الخصوص.العدالة في آراء قدماء الحكماء:أ- سقراط «470- 399ق. م»:يعتقد سقراط بأنّ القانون والعدالة يمثلان دعامتي المشروع الذي يطرحه، والذي يتضمّن الحياة الأفضل. ومراده من القانون، القانون الإنساني الذي يسود كل منطقة وحكومة، أمّا العدالة فهي الانصياع التام لذلك القانون[17].ب- أفلاطون «427- 347ق. م»:لقد نحا أفلاطون منحى أُستاذه سقراط، وغامر وضحّى بحياته في سبيل نشر فلسفته في تلك الظروف السياسية المتوترة، وسعى جاهداً لتأسيس جمهوريته الحديثة -حكومة السماء على الأرض- أو مدينته الفاضلة على أساس أفكاره ومعتقداته. ولم يكن كتابة المعروف «الجمهورية» ليقتصر على النظريات المحصنة، بل كان يسارع مبادراً لإدخالها حيز التطبيق العلمي[18].كان يصطلح على الانسجام والتوافق والنظام الذي يسود عناصر المجتمع بالجمال أحياناً، أو عصر الفضيلة والخير، فيرى العدالة هي ذلك الخير والجمال[19]. ويعتقد بأن العدالة الاجتماعية تعني تفويض كل فرد بما يتناسب وإمكاناته وقابلياته[20].ج- أَرسطو «384- 322ق. م»:أَرسطو هو الآخر يرى بأنّ العدالة نوع من التناسب[21]، ويصرّح بأنّ الحكومة المثالية هي تلك الحكومة التي تهدف إلى إشاعة الرفاه والسعادة في ربوع المجتمع.وليس هناك من أهمية تذكر لشكل الحكومة، إنّما المهم حماس ومعنويات واستقرار - قادتها - رموزها وعناصرها[22]، الذين يضطلعون بمهمة تنفيذ القانون واستتباب العدالة وتهيئة أسباب الراحة للمجتمع.ثم تبعهم سائر الفلاسفة والحكماء في تأكيدهم على مبدأ العدالة. فقد قال «ولتر»: يبدو لي أنّ العدالة من الحقائق ذات الألوية القصوى التي تحظى بقبول العامّة وإن أدّى ظاهرها لارتكاب أَعتى الجرائم[23].البنود الإحدى والثلاثون للميثاق الدولي لحقوق الإنسان هي الأُخرى استهدفت القضاء على الاعتداءات والانتهاكات، والتمييز العنصري، وإقامة النظام العادل الذي لا يسوده الظلم والعدوان. فقد تضمّـنت المطالبة بتوفير الحريات وإحقاق حقوق الأفراد على كافة الأصعدة والميادين[24]؛ وإن كان الواقع العملي خلاف تلك المضامين، بحيث يعدّ الموقعون على تلك البنود أول من تطاول عليها ونقضها وانتهك حرمتها.أمّا على صعيد الفلاسفة المسلمين فيمكن الإشارة إلى الفارابي الذي عكف على دراسة المجتمع نظرياً وبيان متطلباته واحتياجاته في ظل الأجواء والظروف السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك، فألّف عدّة رسائل ومؤلفات في المجال السياسي، أشهرها كتابه المعروف بـ«المدينة الفاضلة»، والذي شبّه فيه المجتمع بالجسد وزعيمه بالقلب الذي ينبغي أن يتحلّىّ ببعض الصفات -من قبيل القوة والحزم، والعزم والفطنة، والولع بالعلم ونصرة العدل- لأنه القائد الذي يدبّر سائر الأنشطة والفعاليات، ويمنحها النظام المطلوب[25].ونرى أنّ هذه الصفات التي قال بها الفارابي -بالنسبة للقائد والزعيم- على غرار تلك التي افترضها أفلاطون في كتابه «الجمهورية» بالنسبة للحكيم، غير أنّ الفارابي أضاف إليها الارتباط بعالم السماء والوحي الإلهي الغيبي، على أنّ القديسين هم عناصر وأفراد تلك المدينة، والأنبياء هم الذين يتولون إدارتها وحكومتها.ثم جاء من بعده الخواجه نصير الدين الطوسي، الذي ذهب إلى أنّ الإنسان موجود اجتماعي بالذات على أساس تجزئة شؤونه وأُموره إلى الأخلاق، تدبير المنزل، والسياسة، فليس هنا ك فرد يعيش حالة الاكتفاء الذاتي، فهو بحاجة إلى عون الآخرين ومساعدتهم، وحيث كانت حاجات الأفراد ومتطلباتهم مختلفة ومتفاوتة، فإنّ ذلك سيؤدي إلى حالة من التنافس والتضارب في المصالح، وبالتالي فلا مناص من ظهور الظلم والعدوان.ومن هنا تبرز ضرورة إقامة الحكومة، ليقنع كل فرد بحقوقه وبحصته التي يستحقها، دون أن يعتدي ويتطاول على الحقوق المشروعة للآخرين.لذلك كانت أُولى وظائف الحكومة -التي ينبغي أن يتزعمها ملك عادل والذي يعدّ الحاكم الثاني بعد الناموس «حكومة الله»- إقامة العدل وبسط القسط. ويخلص الخواجه إلى أنّ هذا الملك هو خليفة الله في الأرض، وهو كالطبيب للعالم ينهض بمسؤولية حفظ نظامه واعتداله[26].ثم حذا حذوه سائر الحكماء والفلاسفة والعلماء الذين تعرّضوا في أبحاثهم لشكل الحكومة القائمة على أساس العدل والقسط، من قبيل ابن سينا[27]، ابن رشد[28]، العلاّمة الطباطبائي[29] وتلميذه الفذ الشهيد المطهري[30]، وبرز في المقدمة وعلى الرأس الإمام الخميني (قدس سره)، حيث اكتسب الألوية والتقدُّم بسبب البعد العملي الذي أضفاه على أبحاثه الواردة في ولاية الفقيه بشأن إقامة الحكومة. وهنا لابد من القول بأنّ بسط العدالة بمعناها الواسع الشامل الذي لا يتخلله أَي نوع من أَنواع الظلم والاضطهاد إنّما هو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، وقد سعى الإمام قدر المستطاع لأن يكسب هذا المفهوم طابعه العملي وممارسته التطبيقية.أهمية العدالة الاجتماعية في القرآن الكريم:تعدّ العدالة على ضوء الرؤية القرآنية إحدى البنى التحتية للمجتمع التي أوجب الشارع إقامتها والعمل على إشاعتها في أوساط الأُمة.فقد قال سبحانه: ?إِنَّ اللـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ...?[31].وقال: ?يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقَّ?[32].وفي هذا الإطار حذر الأُمة المسلمة من الانحراف عن العدالة بسبب ما يبديه العدو من أساليب ملتوية وظلم واعتداء، فقال: ?وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لَلتَّقْوَى?[33].ولذلك كان محور رسالات الأنبياء يكمن في إقامة العدل والقسط. قال تعالى: ?لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُـلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ?[34].وإن انفرد العلاّمة الطباطبائي ليحمل العدل والقسط الوارد في الآية على القسط في المعاملات[35].في حين ذهب سائر المفسرين إلى أنّ المراد مطلق العدالة الاجتماعية، وفي كافة الأصعدة والمجالات، بل وحتى العدالة الاقتصادية، وقد استهدفت آيات العدالة في القرآن الكريم تربية الاُمة وتهذيبها بالشكل الذي يجعلها مؤهّلة لإقامة العدل والقسط، دون الأخذ بالحسبان أَيّ عنصر يمكنه أن يحرفها عن تلك المسيرة من قبيل، المودّة والعداء، القرابة والنَسب، وسائر العوامل المؤثرة في تطبيق العدالة. حتى عَدَّت الانحراف عن العدل بمثابة الضلال واتّباع هوى النفس: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يِكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيرَاً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً?[36]. لقد كان هذا المبدأ القرآني «بسط العدالةِ بين أفراد الاُمّة» مشهوداً في السيرة العملية لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فقد قال الإمام الباقر (عليه السلام): «أَبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل»[37].لذلك انتعش هذا المفهوم في صدر الإسلام، حتى عدّه أمير المؤمنين (عليه السلام) أَفضل من الجود. فقد سئل (عليه السلام) أيّهما أفضل: العدل أو الجود؟ فقال (عليه السلام): «العدل يضع الأُمور مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أَشرفهما وأَفضلهما»[38]. وذلك لأنه (عليه السلام) يرى أنّ العدالة هي التي توجب المساواة الاجتماعية ورضا الأُمة، وتمنحها الطمأنينة والسكينة[39]. ونظراً لأهمية العدالة وخطورتها فإنّ القرآن الكريم عمّمها لتشمل كل قطاعات المجتمع، فمن ذلك أكّد على العدالة في الشهادة: ?... واستشهدوا شهيدينِ... ذلكم أقسطُ عندَ اللهِ? و?.. يحكمُ بهِ ذوَا عدلٍ منكم?[40]، وفي تعدد الزوجات: ?وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ فإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...? و?وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ....?[41].و?... وإِذاَ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ولَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى?[42]، والعدالة في الحكم: ?وَإَذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ...?[43]، والعدالة في كافة شؤون الحياة: ?... كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيـرٌ بمَا تَعْمَلُونَ?[44].وهذا إنّما يكشف عن مدى أهميتها وعظم وقعها. وقد وصفها الإمام علي (عليه السلام) حيث قال: «العدلُ يصلحُ البرية»[45].والذي يفيد أيضاً أنّ سيادة العدل واجتناب الظلم إنّما يؤلف بين القلوب ويجمع شمل الاُمة، ويوجب لحمة طبقات المجتمع وممارسة الحياة السلمية الوادعة. لذلك نهى القرآن وحرم كل ما يمهّد السبيل أمام الفساد والانحراف والتطاول على العدالة -ونعت ذلك بالفسوق- بل حتى الخبر الكاذب الواحد الذي قد يكون لهُ بعض الأثر السلبي على معنويات أفراد الاُمة قد وصفهُ بالفسق والخروج عن العدل.من جانب آخر حثّ القرآن وشدّد على التحلي بالعدالة حتى بالنسبة لشهود المعاملة؛ ليكشف عن مدى أهمية المبدأ السامي، إلى جانب كونه حثاً مباشراً للجميع على الاتصاف بهذه الملكة العظيمة. وبالطبع فإنّ الأُخوة والأنفة والمحبة إنّما تسود أفراد المجتمع المتوزان الذي يتمتع أفراده كافة بالأمكانات الاجتماعية، من قبيل القدرة والثروة والموقع الاجتماعي، بحيث لا تكون الثروات حكراً على بعض الأفراد دون الآخرين، ولذلك نقل عن الإمام علي (عليه السلام) قوله: «العدل مألوف»[46].بالإضافة إلى ذلك فإنّ النظام المبتني على العدالة النظام الذي جهد الأنبياء والأوصياء لأقامته نظاماً ناجعاً متكاملاً.إن إقامة النظام وفاعليته إنّما تعني فاعلية قطاعاته كافة، وذلك لأن بعضها مرتبط بالآخر برباط وثيق يأبى الانفصال والانفكاك. بعبارة أُخرى فإنّ قوام وفاعلية النظام يعتمد على إصلاح وتعديل مؤسساته كافة. فعلى سبيل المثال: إذا أُصلِح القطاع العسكري من جانب في حين يسود الظلم والجور وعدم إجراء العدالة قطاع القضاء والتقنين من جانب آخر، فإنّ ذلك سيؤدي إلى اختلال الوضع الاجتماعي وبروز حالة من الاضطراب والفوضى. وكذا يسود المجتمع حالة من الإرباك وعدم الاستقرار مع سلامة أجهزته القضائية وعدالتها؛ لأنه يعيش حالة من الفساد والانحراف في المجالات الاقتصادية والتجارية مثلاً.لذلك كان الخطاب القرآني -«ليقوم الناس بالقسط»، «اعدلوا» و«قوامين بالقسط»..- يعالج العدالة الاجتماعية المطلقة في كافة المجالات التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر. أمّا المفهوم الذي يقابل العدالة الاجتماعية وأهميتها، فهو الظلم والاضطهاد الذي يختزن مقدمات اضمحلال المجتمع والقضاء عليه. «وليس شيء أَدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم»[47]. والظلم مصدر العداء والبغضاء[48]، وعامل انهيار الحَضارات وزوالها[49]. ويجمع الإمام علي (عليه السلام) مساوئه في كلمة واحدة فيقول: «الجور ممحاة»[50] فدوله لا تعمّر ومجتمعاته قصيرة العمر. تبلور العدالة في ظل الحكومة:إنّ تحقّق العدالة الاجتماعية بصفتها تشكل إحدى غايات رسالة الأنبياء تتطلب تهيئة بعض المقدمات، ومن أبرز وأهم هذه المقدمات بوصفها ضرورة ملحة هو إقامة الحكومة.ولم يكن هدف الأنبياء وأوصيائهم فيما بذلوه من جهد وسعي في سبيل إقامة الحكومة سوى تحقيق العدالة الاجتماعية في نواحي الحياة كافة[51]. فلم يكونوا من اللاهثين وراء الرئاسة والتسلط والهيمنة وتحقيق المصالح الفردية، بل لم تكن للحكومة -عندهم- من قيمة سوى كونها وسيلة لتنفيذ القوانين وإحقاق حقوق المحرومين قال تعالى: ?لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ والْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ?[52].والحق أنّه لا يمكن الوقوف على جوهر الدين، وفهم مشاريعه بشأن تشكيل الحكومة، واقتحام الأنبياء لميدان السياسة، وخوضهم لتلك الصراعات المريرة ضد جبهات الكفر والاستكبار، ومواجهة عناد الملحدين وتجبر الرأسماليين، بمعزل عن تحقيق العدالة وإشاعتها بين الناس. ولو اقتصرت رسالاتهم على الآخرة دون الدنيا لما كان هناك من معنًى لتلك الحملات المسعورة والمجابهات الظالمة التي قادها جناح الكفر ضدهم بهدف عرقلة مسيرة رسالاتهم والوقوف بوجههم.ومما ينبغي الالتفات إليه هو أنّ طبيعة التشريع الإسلامي ومقرراته تستلزم سعي النبي لإقامة الحكومة، وذلك لتعذّر تطبيق بعض القوانين، لاسيما تلك التي تعالج القضايا المالية.فقد سعى الأنبياء (عليهم السلام) كسليمان بن داود (عليهما السلام) والرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل بيته (عليهم السلام) لإقامة الحكومة بغية بسط العدل والقسط والحيلولة دون الظلم والجور وعليه: «فإنّ إقامة الحكومة تعدّ من أعظم الواجبات والسعي إليها من أَفضل العبادات»[53].ومن هنا نستنتج بأنّ الحكومة لا موضوعية لها، بل هي كما وصفها أمير المؤمنين (عليه السلام) حين دخل عليه ابن عباس وهو يخصف نعله، فقال له: «يا بن عباس ما قيمة هذا النعل؟» قال: لا قيمة لها! فقال (عليه السلام): «والله لهيّ أَحبّ إليّ من إمرتكم، إلاّ أن أُقيم حقّاً، أَو أََدفع باطلاً»[54].وقال (عليه السلام) بهذا الشأن أيضاً: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَلا الْتِمَاسَ شَيءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ، وَلَكِنْ لِنَرُدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِيِنكَ، وَنُظْهِرَ الصلاحَ فِي بِلادِكَ، فَيَأمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُقَامَ الْمُعطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ...»[55].عدالة الهيئة الحاكمة:إنّ تشكيل الحكومة وإن كان من أوجب المقدمات وأهم الوسائل لإقامة العدالة الاجتماعية، إلاّ أنّ القرآن لم يترك الحاكم سدى في ممارسته لتلك الحكومة، بل افترض تمتعه ببعض الصفات والخصال التي تؤهله لأن ينهض بمسؤولية بسط العدل في المجتمع.ولا تختص هذه الصفات بشخص الحاكم فحسب، بل ينبغي توافرها في الجهاز الحاكم وفي كل عضو من أعضاء الحكومة الإسلامية بما ينسجم وطبيعة مهامه ووظائفه؛ أَي لابد أن تتصف الهيئة الحاكمة بتلك الخصال، وإلاّ فلا يمكن أن يتصور إمكان بلوغ المجتمع ذلك الهدف -أي العدالة الاجتماعية-. ونشير هنا إلى أهم تلك الصفات:أ- العلم والإلمام بالضوابط والقوانين الإسلامية لاسيّما تلك التي تعالج الجانب الاقتصادي:فهذا شرط ينبغي أن يتوافر في كافة مسؤولي الحكومة الإسلامية. فقد قال سبحانه وتعالى: ?قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ?[56]، و?يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والَّذِينَ أُوتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ?[57]، و?قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنَّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ?[58].وقال الإمام علي (عليه السلام): «إنّ أحقَ الناسِ بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه»[59].وبالطبع فإنّ هنالك ما هو أهم من العلم، ألا وهو الرؤية العميقة الصائبة للقوانين والمقررات والوقوف على الضروريات والأولويات في هذا المضمار. فالتفاسير والقراءات الخاطئة للدين، لاسيّما في المجال الاقتصادي إنّما تشكّل عقبة كؤوداً تعترض طريق تحقّق العدالة الاجتماعية. فتيارات الانحراف، التحجّر، وأنصار الإسلام المنحرف هم الآخرون من دعاة العدالة الاجتماعية، غير أنّ استنتاجاتهم لا تمتّ بصلة لما صرّح به القرآن في هذا المجال، من اشتراط العلم والاطلاع والرؤية الإسلامية الصائبة -في الحاكم الإسلامي- المستندة للنصوص الدينية والثقافة الإسلامية ولسيرة أئمة الدين ونظراتهم للعدالة الاجتماعية.ب- الاعتقاد بكفاءة الإسلام:لابد من إيمان الهيئة الحاكمة بقدرات وكفاءة المقررات والقوانين الإسلامية وفاعليتها في ميدان الممارسة والتطبيق، إلى جانب امتلاك الرؤية الصحيحة للإسلام فإنّ الاعتقاد المذكور يمثل الشرط الآخر الذي ينبغي توافره فيمن يروم تحقيق العدالة الاجتماعية. فقد قال علي (عليه السلام): «لا يعدل إلاّ مَن يُحسن العدل»[60].فليس بوسع كل فرد أن يسعى لتحقيق العدالة سوى ذلك الذي يراها مبدأً سامياً لابد أن يسود المجتمع، فلا يتسنى تحقيقها لمن لا يمتلك مثل هذا الاعتقاد بأحكام الإسلام ونظرياته، وإلاّ فإنّ حب الرئاسة والرفاه المادي ستكون هي الدوافع الأساسية لمن يتقبل بعض المسؤوليات في النظام الإسلامي. ج- العدالة: إحدى مميزات رجالات النظام الإسلامي الاتصاف بالعدل، والنفرة والابتعاد عن الذنب. فقد اشترط الإسلام العدالة عند التصدي لمختلف المسؤوليات -وإن قال بتفاوت واختلاف درجاتها بحسب المسؤوليات المختلفة- من قبيل إمامة الجماعة، القضاء وتولي شؤون المجتمع. فأنّى لمن تبع هواه وكان أسير شهواته، فاقداً لحالة التوزان والتعادل النفسي أن ينهض بأعباء هداية المجتمع وتطبيق العدالة؟ فإقامة العدل أنما تتوقف على قوة الإيمان، الورع والتقوى، نوع النظرة للإنسان والعالم والهدف من الخلقة وعالم التكوين.فهناك بعض العناصر التي تلعب دوراً مهماً في إقامة العدالة، كما يمكنها أن تبعد الحكام والولاة عن جادة الاعتدال والإنصاف، من قبيل، الحب والبغض، النظرة للإنسان، الفقر والغنى، والمعنويات والأخلاق. ومما تقدم تتعين ضرورة عدالة الحكّام، وكبحهم لجماح شهواتهم وحبهم للرئاسة والنفعية، بما يتحلون به من إيمان وورع وتقوى. بل وأن ينظروا للحكومة والمنصب كما وصفه الإمام علي (عليه السلام): «وأنّ عملكَ ليسَ لكَ بطعمةٍ ولكنه في عنقك أَمانة....»[61].والحق أنّ هذا صراط أَحدّ من السيف، وأدقّ من الشعرة، فقد قال علي (عليه السلام): «داووُا الجورَ بالعدلِ»[62]. فالسبيل الوحيد الذي يمكن بسلوكه إزالة هذا الانحطاط والتخلّف عن المجتمعات وضمان سلامة مسيرتها إنّما يكمن في ترسيخ العدالة والعمل بها، إلاّ أنّ ذلك يتطلب سبق المسؤولين لئن ينهضوا بهذا الأمر وإلاّ كما قال الإمام علي (عليه السلام): «كيفَ يعدلُ في غيره من يظلمُ نفسَه»[63]. وقال (عليه السلام) أيضاً: «لا يقيمُ أمرَ اللهِ إلاّ من لا يُصانع ولا يضارع ولا يتّبع المطامع»[64]. دور العدالة الاجتماعية في تطور البشرية وتكاملها: إنّ الهدف من خلقة البشرية بلوغها الكمال، وهناك العوامل التي لها بالغ الأثر في تحقق هذا الهدف من قبيل السعي والعمل والطموح والإعمار وما إلى ذلك؛ إلاّ أن أهم عنصر يمكنه أن يساهم في تعبئة المجتمع البشري ويبلغ به الكمال المنشود إنّما يكمن في العدالة الاجتماعية. فإذا ما شعر كل عضو في المجتمع بأنّ الآخرين يراعون حقوقه ويحرصون على احترام كرامته ومبادئه، سعى جاهداً لتوطيد علاقاته مع سائر الأعضاء، وساهم حسب ما في وسعه لرفد المجتمع بطاقاته وإبداعاته بما يدفع عجلة رقيه وتطوره للأمام. فالمجتمع كالجسم الذي تتوقف فعاليته وحيويته على سلامة ونشاط سائر أعضائه. ومما لاشك فيه أنّ نهوض المجتمع وتطوره إنّما يعتمد بالدرجة الأساس على مدى تعاون أفراده فيما بينهم من جهة، ومدى تكاتفهم مع الجهاز الحاكم وبالعكس من جهة أُخرى. إلى جانب ذلك فإن تغييب العدالة إنّما يعني غياب النشاط والحيوية، الرقي والازدهار، الكمال، روح التعاون بين أفراد المجتمع وبالتالي اضمحلاله وانهياره. إنّ الظلم يمثل آفة المجتمع وعنصر زوال الحضارة وانقراض الأقوام والأُمم، «فالفرد والمجتمع اللذان لا يصلحهما العدل سيكونان كالريشة في مهب ريح الجور والظلم»[65]. إنّ التمييز والظلم لا يستتبع سوى تقوقع وانعزال المجتمع وانحطاطه، والحيلولة دونه ودون التحلي بالوعي واليقظة والتوافر على سمو الخلق، بل يمهّد السبيل أمام زوال حضارته وانعدام تكامله المادي والروحي. وليس له أَن يستعيد حيويته ونشاطه ويأخذ بأسباب التقدّم والنهوض إلاّ في ظل العدالة التي لها القدرة على اجتثاث جذور البغض والعداوة من أعماقه لتحل محلها الألفة والمحبة والثقة، وليس هذا من قبيل الاستنتاجات الأخلاقية المحضة، بل هذا ما تشهده بالتجربة كافة قطاعات المجتمع بأفراده وشرائحه ومنظماته ومؤسساته. والآيات القرآنية لتكشف بوضوح عن مدى فاعلية العدالة في تهذيب الأخلاق، وإصلاح المسيرة الفردية والجماعية، والأخذ بيدها نحو السمو والكمال، فقد قال سبحانه: ?..ولْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ولْيَتَّقِ اللهَ رَبَّه وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أو لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَليُّهُ بِالْعَدْلِ... ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ....?[66].«فالعدالة محور الحياة البشرية، هي التسامي والتكامل، وهي رفض التراجع والانهيار والسقوط بالنسبة للفرد أو المجتمع إذا ما جعلها محوراً لحياته وممارساته، والعكس صحيح، فإنّ الفرد أو المجتمع إذا ما أقصى العدالة عن حياته، مهّد السبيل أمام تآكله وانقراضه.ومما لاشك فيه أن سقوط الحضارة وانهيار المجتمع لا يعني بالضرورة موت أفراده وانهيار عناصر مدنيته وسقوط أبنيته وعماراته، بل إنما تسير حضارة المجتمع ومؤسساته نحو الانهيار والاضمحلال منذ ممارسته لأساليب الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري، وتضييع حقوق الأفراد، وعدم الاعتناء بها، واستثمار طاقاتهم وجهودهم والنظرة إليهم على أّنهم أشياء لا أفراداً يتمتعون بالمشاعر والأحاسيس ولهم متطلباتهم وقيمهم»[67].ونخلص مما سبق إلى أنّ المجتمع الذي تسوده العدالة في ميادينه كافة، سيكون مجتمعاً نامياً متطوراً يتمتع بأسباب الرقي والتكامل الذي ينسجم والرقي الحضاري والسير التكاملي الذي تشهده سائر المجتمعات البشرية. وعليه الحذر واليقظة من أية ممارسة تناهض العدالة لأنها تستلزم تراجع المجتمع القهقرى ثم سقوطه.ومما يجدر ذكره هو أنّ الأنبياء أيضاً قد بعثوا لتحقيق التكامل عبر الحق والعدل والقسط.ونخلص مما سبق إلى الارتباط الجدلي الوثيق بين العدالة الاجتماعية والتنمية على ضوء مفهومها الإنساني، فلا يمكن بلوغ التنمية بكافة أركانها دون إقامة العدل وتوسيع رقعته، وذلك لأنّ التنمية قضية تستلزم الانتعاش والازدهار المتواصل على كافة ميادين الحياة البشرية: المادية والروحية، الاجتماعية والسياسية للفرد والمجتمع، وفي ظل هذه الأجواء يحظى الفرد بعزة النفس والاعتماد عليها إلى جانب اتساع دائرة حريته واختياره ضمن الاُطر المعروفة[68]. تجسّد العدالة الاجتماعية في التنمية والعدالة الاقتصادية:إنّ العدالة الاجتماعية ليست مقولة ذهنية مجردة محضة، بل هي مسألة واقعية وعينية على مختلف الأصعدة والمجالات. وإن الخط البياني لهذا الأمر العيني يتجسّد في العدالة الاقتصادية.في الواقع إنّ تبلور حكومة العدل والقوانين الهادفة للعدالة إنّما يمكن ملاحظتها والوقوف على معالمها من خلال النظر في المجال الاقتصادي والمعيشي للمجتمع، والذي يشكل بدوره جزءاً لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، وضرورة من ضروراتها.إنّ العدالة الاقتصادية تعني: «المساواة في الإمكانات، العدالة في توزيع الثروة، التوزيع العادل للمواد الأولية الطبيعية على أفراد المجتمع، المساواة في توفير فرص العمل، والتمتع بالحق القانوني الذي يتضمن القيمة الواقعية للعمولة مع الحق الواقعي (الحصة) للأفراد»[69].تحظى العدالة بمكانتها الخاصة في النظام الاقتصادي للإسلام؛ والذي يتضمن البرامج العدالة في كيفية توزيع المواد الأولية وتوزيع الثروات الإنتاجية. ومما لاشك فيه أنّ عملية التوزيع العادل للمصادر الطبيعية والثروات الأولية إنّما تلعب دوراً حيوياً بالغ الأهمية في سلامة النظام الاقتصادي للمجتمع. فإذا ما احتكرت هذه الثروات والمصادر من قِبل بعض الأفراد أو الجماعات، ظهرت الطبقية والتمايز في المجتمع ومهّد السبيل أمام التسلط والاستغلال. لذلك طرح الشهيد السيد محمد باقر الصدر النظرية الاقتصادية وفق الرؤية الإسلامية مخالفاً المدرسة الاقتصادية السياسية الكلاسيكية، والتي يحتلّ بحث الإنتاج الصدارة فيها، فقد ذهب الشهيد الصدر إلى أنّ المذهب الاقتصادي الإسلامي إنّما اهتم بادئ ذي بدء بالتوزيع الذي تقدم مرحلة على الإنتاج. يقول الشهيد الصدر: «ومن الواضح أنّ توزيع المصادر الأساسية للإنتاج يسبق عملية الإنتاج نفسها، لأنّ الأفراد إنّما يمارسون نشاطهم الإنتاجي وفقاً للطريقة التي يقسّم بها المجتمع مصادر الإنتاج، فتوزيع مصادر الإنتاج قبل الإنتاج، وأمّا توزيع الثروة المنتجة فهو مرتبط بعملية الإنتاج ومتوقف عليها، لأنه يعالج النتائج التي يسفر عنها الإنتاج»[70]. والجدير بالذكر أنّ بحث العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام ليس منفصلاً عن الهدف الأصلي للدين (والذي يكمن في السمو الروحي للإنسان على صعيدي العلم والعمل). لذلك كان اهتمام المدرسة الإسلامية بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بسبب تأثيرهما المباشر، كونهما تمثلان الأداة الحية الفاعلة في بلوغ ذلك الهدف السامي، وقد استهدفت بعض التعاليم الاقتصادية في الإسلام تربية الإنسان وتهذيبه، الأمر الذي يجعل هذه المسألة تصبّ هي الأُخرى في إطار ذلك الهدف المقدس؛ ومن ذلك -على سبيل المثال- اشتراط النيّة وقصد القربة في أداء الخمس والصدقة، وذلك لسدّ حاجات الفقراء وإيجاد حالة من التوازن الاقتصادي من جهة، وكونه يمثل ذكر الله وتقرباً إليه من جهة أُخرى، إلى جانب تمرين الفرد على النأي بنفسه بعيداً عن التعلق بأموال الدنيا وزخارفها، ولذلك فدورهما التربوي لا يخفى في هذه الأُمور. والحق أنّ الإسلام يرى الأخلاق والاقتصاد حقيقة واحدة تأبى الانفصال. على كل حال فإنّه لا يمكن النظر إلى العدالة الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على أَنّها منفصلة عن سائر مبادئ الدين وأُصوله.لقد قيل آنفاً بأنّ تحقق العدالة يعد أحد الأهداف الاجتماعية لبعثة الأنبياء قال تعالى: ?لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ?. فقد ألمحت الآية إلى أنّ العدالة الاجتماعية على جميع الأصعدة ومنها الصعيد الاقتصادي، لتمثل هدفاً مهماً من أهداف البرامج الإصلاحية الرسالية التي قاد مسيرتها الأنبياء العظام. هذا وقد صرحت آية أخرى قائلة: ?إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ والْبَغْي?[71].ويبدو من سياق هذه الآية أنها تعرضت لوظائف الأفراد إزاء المجتمع، إنّ المراد بالعدل هو العدل الاجتماعي وأن أفراد الأُمة مكلفون من قبل البارئ بإقامة العدالة الاجتماعية وبمعناها المطلق الذي يشمل كافة الصعد والميادين، والتي تعدّ العدالة الاقتصادية إحداها وأبرزها.وحيث تتعذر فاعلية العدالة بمفردها -رغم انطوائها على كل مقومات القوة والتأثير العميق - في الحالات الطارئة والاستثنائية، فقد أُردفت بالأمر بالإحسان؛ وذلك لحاجة المجتمع في تلك الظروف الشائكة للإيثار والتضحية، والتي لا تتأتى إلاّ في ظل الإحسان[72].وقد علّق صاحب تفسير النار على هذه الآية الكريمة بالقول: إنّ حدة العدالة وقاطعيتها إنما تخف وطأتها بالإحسان والإيثار والتفضل.وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «جماع التقوى في قوله تعالى: ?إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ?»[73]. وروي عن الصحابي الجليل ابن مسعود قوله: «إنّ هذه الآية جامعة لكل آيات الخير والشر»[74]. وتدلّ سائر الآيات من قبيل: ?وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ?[75]، ?قُلْ أَمَرَ رَبَّي بِالْقِسْطِ?[76]، والآية ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ للهِ?[77] بصورة عامة على مطلوبية العدالة بكافة أبعادها. لاسيما في المجال الاقتصادي، وأن أحد أهداف الشريعة الإسلامية المقدسة إنّما في إقامة العدل والقسط في الجانب الاقتصادي[78]. وما ينبغي الالتفات إليه في هذا المجال هو أنّ العدالة الاقتصادية في الإسلام مرتبطة بالأوضاع الداخلية للمجتمع الإسلامي وشاملة لكافة أفراده بما فيهم أَهل الذمة. فقد قال تعالى: ?لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدَّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَاركُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ?[79]. عناصر التنمية والعدالة الاقتصادية:تهدف كافة المذاهب الاقتصادية لتحقيق العدالة؛ إلا أن هناك اختلافات جذرية في تفسيرها وتعريفها. ومن هنا تبرز ضرورة دراسة العناصر المؤثرة في العدالة الاقتصادية من وجهة نظر المدرسة الإسلامية. فالإسلام يرى أنّ العدالة الاقتصادية قائمة على عنصرين مهمين هما: الرفاه العام، وتعديل الثروة: «فالركن الأساسي في الاقتصاد الإسلامي، هو مبدأ العدالة الاجتماعية التي جسّدها الإسلام فيما زوّد به نظام توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وضمانات، تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة الإسلامية»[80].أ- الرفاه العام:ما ينبغي أن تكون عليه الأوضاع المعاشية في المجتمع الإسلامي هو أن يتمتع كافة أفراده على قدر الكفاف بجميع الإمكانات وفي كافة المجالات (الصحية، الوقائية، التغذية، التعليم، السكن و...).ويتطلّب هذا المفهوم للرفاه العام اجتثاث جذور الفقر من المجتمع، كما لا يقتضي في الوقت نفسه أن يكون هدفاً مستقلاً عن الأهداف الاقتصادية.وسنتعرض هنا بصورة مقتضبة إلى مدى تأثير مفهومي الفقر والغنى في الإقتصاد، حيث تنوعت بشأنها وجهات النظر على ضوء تعدد المذاهب الفكرية والاجتماعية، ولا يخفى تأثير هذه الآراء على السلوك الاقتصادي لأتباع تلك المدارس الفكرية والمذاهب الاقتصادية.فالفقر -مثلاً- مقدّس في المذهب الذي يقول بتفاهة الثروة وانحطاط قيمتها، في حين تنعكس القضية تماماً بالنسبة لمذهب آخر لا يتّفق والمذهب المذكور، ومن هنا شهدت المذاهب الاقتصادية بوناً شاسعاً في الرؤى والفلسفات الواردة بهذا الشأن.وهنا نقول: إنّه يمكن الوقوف على الصورة الحقيقة لمفهومي الفقر والغنى من خلال الآيات والروايات التي وردت بخصوصهما. فقد ألمحت الآيات القرآنية وروايات المعصومين (عليهم السلام) لأربعة مفاهيم للفقر والغنى، والمفاهيم الثلاثة الأُولى لهما لا تعالج القضية الاقتصادية.فقد ورد المفهوم الأول بمعنى أنّ المراد بالفقر هو الفقر الذاتي وحاجة الإنسان الدائمة لله. فقد قال سبحانه: ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ?[81].أما المفهوم الثاني للفقر فهو أنّ المراد به فقر النفس. فالإنسان الذي يرى نفسه أسيراً وعبداً للمال والمنصب إنما يكشف في الواقع عن جذور الفقر المتأصلة في روحه وأعماقه والتي تمثّل أسوأ أنواع الفقر. فقد قال الإمام علي (عليه السلام): «فقر النفس شر الفقر»[82]. وهذا ليس إلّا الطمع والحرص الذي يسلخ الحياة عن النفس، فيتركها شبحاً لا حركة فيه، وفي هذا الصدد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إياكَ والطمع، فإنّه فقر حاضر، وعليك باليأس عمّا في أَيدي الناس»[83].ويمثّل هذا الفقر نوعاً من الأمراض النفسية والخواء الروحي. حيث يزداد صاحبه فقراً وطمعاً كلما ازداد كسباً وجمعاً. ودواؤه الناجع هو الغنى عن الآخرين وعدم الاكتراث لمناصبهم ومقاماتهم.المفهوم الثالث هو فقر المعرفة، والغفلة عن معارف الكون وحقائقه، وتقابله البصيرة والدراية. فقد قال علي (عليه السلام): «لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل»[84]. أمّا المفهوم الرابع والذي نروم التعرض له في هذا البحث فهو الفقر والغنى المالي، ولا ترى المدرسة الإسلامية من مبرر لهذا الفقر، وتعتقد بأنّه أَمرٌ كريه مستهجن ويشكل بؤرة المشاكل الأخلاقية والمعضلات الاجتماعية.الفقر هو العنصر الذي يختزن كافّة أسباب شقاء البشرية وبؤسها. بل إليه تعزى جذور الجريمة والفساد والانحراف. وليس هناك من دليل أَدلّ على ضرورة تحقيق الرفاه العام للأفراد وتلبية حاجاتهم المعاشية وممارستهم للكفاف من تنفّر المجتمع من الفقر وذمه.فقد صوّر لقمان الحكيم الفقر قائلاً: «ذقت المرارات كلها فما ذقت شيئاً أَمرّ من الفقر»[85].ونُقل عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّ إبراهيم الخليل (عليه السلام) قال: إلهي إنّ الفقرَ لأشد من نار نمرود»[86]. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أَربعة قليلها كثير: الفقر والوجع والعداوة والنار»[87]. وقال علي (عليه السلام): «يا بني إنّي أَخاف عليكَ الفقر فاستعذ بالله منه، فإنّ الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعية للمقت»[88]. وقال في موضع آخر: «الفقر، الموت الأكبر»[89]. وقال (عليه السلام): «لو كان الفقرُ رجلاً لقتلته»[90].لذلك صرّح القرآن بمعالجة الصدقات للفقر (بهدف إيجاد حالة من التوازن الإجتماعي ورفع الفقر وإشاعة الرخاء العام): ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء?[91]. ثم رأى أن خشية الفقر تمثل إحدى مصائد الشيطان وشباكه. فقال عزّ من قائل: ?الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ?[92]. وناهيك عن كل ما تقدم فإنّ الأسوأ من الفقر هو الشعور به وبقلة ذات اليد، ولذلك قال علي (عليه السلام): «إنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفِة النَّاسِ كَي لا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ»[93].فقد عَدَّ هذا الشعور أقرب ما يكون للكفر: «كادَ الفقر أن يكونَ كفراً»[94]. إن الفقر المالي لمذموم وجامع لكل آثار السوء الأخلاقي والاجتماعي[95]، إلاّ أنّ فقر النفس يعدّ أكثر سوءاً وأعظم خطراً وأفدح ضرراً. وليس للغنى المالي القدرة على الحد من الفقر والحيلولة دونه؛ فربما يشعر مثل هؤلاء الأفراد بفقرهم حين مقارنة أَنفسهم مع الآخرين رغم تمتعهم بكافة أسباب الراحة والرخاء، والعكس صحيح فكثير من الأفراد الذين يئنون من الفقر والعوز قد يعيشون في باطنهم حالة من الهدوء والاستقرار، ويرون أنفسهم أغنياء عمّا في أيدي الآخرين. وهذا ما يصطلح عليه بـ«الاستغناء» الذي يمثل قمة الغنى وأَشرفه. ولا يبلغ الفرد هذه المرتبة إلاّ إذا عاش حالة التوكل التي حثّ عليها الشارع المقدس. فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أَراد أَن يكون أَغنى الناس فليكن بما في يد الله أَوثق منه بما في يد غيره»[96]. وعليه فالذي يتضح من التعاليم الإسلامية هو أنّ الفقر -إذا لم يرافقه استغناء للنفس- مذموم مستهجن، ولابد من تمتع أفراد المجتمع بكافة الإمكانات التي تساهم في تحقيق الرفاه والرخاء الاجتماعي، لاسيّما إذا لم يصدهم المال والثروة عن ذكر الله، وكان لهم عوناً على خشية الله والتقرب إليه[97].فالثروة وأَساليب تنميتها التي تحجب الإنسان الرسالي عن ربه، وتنسيه أَشواقه الروحية وتعطّل رسالته الكبرى في إقامة العدل على هذا الكوكب وتشدّه إلى الأرض لا يقرّها الإسلام، والثروة وأساليب التنمية التي تؤكّد صلة الإنسان الرسالي بربه المنعم عليه، وتهيئ له عبادته في يسر ورخاء وتفسح المجال أَمام كل مواهبه وطاقته للنمو والتكامل، وتساعد على تحقيق مثله في العدالة والأخوة والكرامة هي الهدف الذي يضعه الإسلام أَمام الإنسان الرسالي، ويدفعه نحوه.في حين تقود الثروة صاحبها إلى الضلال إذا ما ظنّ أنّها تغنيه عن الله، ولذلك ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «إنّما أتخوف على أُمتي من بعدي ثلاث خلال.. أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا..»[98].ونخلص مما سبق إلى أنّ العدالة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي إنّما تعني القضاء على الفقر وتوفير الرفاه العام (عيش الكفاف)؛ ولذلك كانت الآيات التي تحث على الإنفاق على الفقراء (من قبيل الخمس، الزكاة، الصدقات و..) إنّما تنظر لهذا الإنفاق على أنّه أحد الطرق التي تقود للرفاه والرخاء الذي يُعَدُّ من أَهم أَهداف المذهب الاقتصادي الإسلامي.?مَّا أَفَاء اللَّـهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ?[99].?وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ?[100].?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ?[101]. ?لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ?[102]. ?وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ?[103]. الروايات هي الأُخرى تضافرت بالأساليب التي انتهجتها حكومة النبي والأئمة المعصومين في تعاملها مع الفقراء والمساكين، والتي تكشف بوضوح عن إيصالهم لحالة الرخاء والرفاه على أنّه يشكّل أحد أهم عناصر العدالة الاقتصادية[104].فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): «يعطى الفقير من الزكاة ما يجعله مستغنياً»[105].وقال: «يعطى منها حتى يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج ويتصدّق ويحج البيت»[106].والنتيجة الحتمية لذلك تحقيق رفاه المجتمع وضمان عيشه وإزالة فقره، وهذا من أهم أهداف الاقتصاد في الإسلام. ب- التقسيم العادل للثروة: العنصر الآخر الذي تقوم عليه النظرية الاقتصادية في الإسلام هو التقسيم العادل للثروة: «فيما يتصل بالنظر إلى الثروة كهدف أصيل يمكننا أن نحدد نظرة الإسلام إلى الثروة في ضوء النصوص التي عالجت هذه الناحية، وحاولت أن تشرح المفهوم الإسلامي للثروة والقائم على أساس تفتيتها وعدم حصرها على طبقات معينة من المجتمع»[107].فلا ينبغي أن يشهد المجتمع الإسلامي حالة الطبقية البغيضة، والاختلاف الفاحش بين أفراده من ناحية استثمار الإمكانات المادية المتاحة. وإن تعذر إنكار الفوارق التي تحكم الإفراد، في حصولهم على الأموال والثروة، وذلك لأنّ هذه الفوارق تكوينية في الأفراد فهم مختلفون من حيث قابلياتهم الجسدية، الروحية، الصبر، الشجاعة، الطموح، الذكاء وسائر القدرات التي زودوا بها. ولم تنشأ هذه الفوارق إثر أوضاع اقتصادية معينة كانت لصالح طبقة اجتماعية خاصة أثرت على حساب طبقة أُخرى. ولذلك كان القضاء عليها ليس ممكناً ولا مفيداً؛ بفعل دورها العظيم الذي دفع قدماً بقافلة التحضر الإنساني، إلى جانب تمهيدها السبيل أمام المجتمع للنهوض والرقي والازدهار. «حين عالج الإسلام قضية التوازن الإجتماعي، ليصنع منه مبدأً للدولة في سياستها الاقتصادية، انطلق من حقيقتين إحداهما كونية، والأخرى مذهبية. أمّا الحقيقة الكونية فهي: تفاوت أَفراد النوع البشري في مختلف الخصائص والصفات، النفسية والفكرية والجسدية. فهم يختلفون في الصبر والشجاعة، وفي قوة العزيمة والأَمل، ويختلفون في حدّة الذكاء وسرعة البديهة، وفي القدرة على الإبداع والاختراع، ويختلفون في قوّة العضلات، وفي ثبات الأعصاب، إلى غير ذلك من مقدمات الشخصية الإنسانية التي وزعت بدرجات متفاوتة على الأفراد. وهذه التناقضات ليست في رأي الإسلام ناتجة عن أَحداثٍ عرضية في تاريخ الإنسان، كما يزعم هواة العامل الاقتصادي، الذين يحاولون أَن يجدوا فيه التعليل النهائي لكل ظواهر التأريخ الإنساني فإنّ من الخطأ محاولة تفسير تلك التناقضات والفروق بين الأفراد، على أساس ظرف اجتماعي معين، أو عامل اقتصادي خاص؛ لأنّ هذا العامل أَو ذلك الظرف، لئن أَمكن أَن تفسر على ضوئه الحالة الاجتماعية ككل، فيقال: إنّ التركيب الطبقي الإقطاعي أَو أَنّ نظام الرقيق كان وليد هذا العامل الاقتصادي، كما يصنع أَنصار التفسير المادي للتاريخ. فلا يمكن بحال من الأحوال أَن يكون العامل الاقتصادي، أَو أَيّ وضع اجتماعي، كافياً لتفسير ظهور تلك الاختلافات والتناقضات الخاصة بين الأفراد.وإلاّ فلماذا اتخذ هذا الفرد دور الرقيق، وذلك الفرد دور السيد المالك؟! وأصبح هذا الفرد ذكياً قادراً على الإبداع، والآخر خاملاً عاجزاً عن الإجادة؟!ولماذا لم يتبادل هذان الفردان دورهما ضمن إطار النظام العام؟!ولا جواب على هذا السؤال دون افتراض أن الأفراد مختلفون في مواهبهم وإمكاناتهم الخاصة، قبل كل تفاوت اجتماعي بينهم في التركيب الطبقي للمجتمع، لكي يفسر تفاوت الأفراد في التركيب الطبقي، واختصاص كل فرد بدوره الخاص في هذا التركيب، على أساس الاختلاف في مواهبهم وإمكاناتهم.فمن الخطأ القول: بأنّ هذا الفرد أَصبح ذكياً لأنّه احتل دور السيد في التركيب الطبقي وذاك أَصبح خاملاً لأنّه قام بدور العبد في هذا التركيب، لأنّه لابد لكي يحتل هذا دور العبد، ويحظى ذاك بدور السيد أَن يوجد فارق بينهما مكّن السيد بإقناع العبد بتوزيع الأدوار على هذا الشكل. وهكذا ننتهي حتماً في التعليل إلى العوامل الطبيعية السيكولوجية التي تنبع منها الاختلافات الشخصية في مختلف الخصائص والصفات.فالاختلاف بين الأفراد حقيقة مطلقة وليس نتيجة إطار اجتماعي معين. فلا يمكن لنظرة واقعية تجاهلها، ولا لنظام اجتماعي الغاؤه في تشريع، أو في عملية تغيير لنوع العلاقات الاجتماعية»[108].حتى أسند القرآن الكريم مثل هذه الاختلافات والفوارق للحكمة والتدبير الإلهيين «فهذا الاختلاف ضروريّ الوقوع بين بني الإنسان لاختلاف الخلقة باختلاف المواد، وأن كان الجميع إنساناً بحسب الصورة الإنسانية الواحدة، والوحدة في الصورة تقتضي الوحدة من حيث الأفكار والأفعال بوجه، ولذلك اختلفت الأغراض والمقاصد والآمال، واختلافها يؤدي إلى اختلاف الأفعال»[109].?مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّـهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا?[110].وعليه فإنّ الإسلام في الوقت الذي يقرّ بحقيقة الفارق التكويني للأفراد في استعداداتهم المادية والروحية، غير أنّه لا يقرّ الطبقية والاختلافات الفاحشة بين أفراد وطبقات المجتمع في اقتناء واستثمار الإمكانات المادية بغية حصول حالة التوازن في المجتمع، والتي تقود بالنتيجة لتحقق العدالة الاقتصادية.وتعزى أسباب ذلك إلى ما يلي:أولاً: إنّما تؤدى الثروة الفاحشة بأغلب الأفراد إلى الغفلة عن الله والأنغماس في الأهواء واللذات الشيطانية: ?أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ?[111].فالمعنى من خلال سياق الآية الكريمة: شَغلكم التكاثر في متاع الدنيا وزينتها، والتسابق في تكثير العدّة والعددّ عمّا يهمكم وهو ذكر الله، حتى لقيتم الموت فعمّتكم الغفلة مدى حياتكم»[112].ثانياً: لو تجمعت الثروة في مكان، أو كانت حكراً على جماعة، لضاع الإحسان والمعروف في المجتمع، وشعر الفقراء بفقرهم وحاجتهم، ولأُصيب الأثرياء بالفخر والغرور وبطر النعمة، مما يضطر الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع وبغية سد حاجاتها لممارسة الأعمال الدنيئة المنبوذة في المجتمع[113].الأمر الذي لم يجعل الإسلام يكتفي ويقنع بالوصايا والإرشادات الأخلاقية بغية الحيلولة دون شيوع الفقر واستفحال أمره بين أَفراد المجتمع، بل حدّد السبل والوسائل التي تهدف لتقسيم الثروات والحد من التمايز الطبقي، الذي ينشأ إثر الاستثمارات المادية القصوى لبعض الطبقات دون الأُخرى وهذا ما يشكل أهم أهداف المذهب الاقتصادي الإسلامي.ولا يعني هذا أنّ الإسلام يمارس بعض الأساليب التي تجعله يقف حائلاً أمام بعض الأفراد من ذوي القدرات والمهارات، ليحول دونهم ودون السعي والنشاط والحصول على الثروات. لكنه ينظر لهذا الأمر من خلال القيام ببعض الأُمور وهي:1ـ أخذ حقوق الفقراء من الأغنياء:عادة ما يقتني ويجمع الأثرياء أموالاً طائلة إثر امتناعهم عن دفع حقوق الآخرين، ولذلك كانت إحدى وظائف الدولة الإسلامية تنظيم وتفتيت هذه الثروات والحيلولة دون نموها واستفحالها بشكل مفرط. وبغض النظر عن هذا الأمر فإن طبيعة الأحكام الإسلامية في المجال الاقتصادي تقتضي عدم ظهور ذلك الثراء الفاحش فقد صرح القرآن الكريم بهذا الشأن قائلاً: ?وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ?[114].فالآية القرآنية وسائر الآيات الواردة بهذا الشأن صريحة في نهيها عن اكتـناز الثروة والأموال الطائلة وتدوالها بين عدة معدودة من الأفراد أو الطبقات، ولذلك فقد ورد فيها هذا النهي من جانب، والأمر من جانب آخر بالإنفاق كونه يشكل أحد الطرق لتقسيم الثروة تقسيماً عادلاً وموازنتها في المجتمع بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية.وقد قال الإمام الرضا (عليه السلام) مشيراً لفلسفة تشريع الزكاة: «إنما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموال الأغنياء»[115].إنّ القرآن الكريم يصرّح بحقٍ للفقراء والمحرومين في أموال الأغنياء فقال عز من قائل: ?وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ?[116].فإذا لم يؤدوه كانوا سارقين لأموال الفقراء[117]. والحق أن ذنوب الأغنياء هي التي أَدت لظهور الفقر والحرمان في صفوف المجتمع.عن الإمام الصادق (عليه السلام): «وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء»[118]. «واللهُ سائلهم عن ذلك يومَ القيامة»[119]. وعليه فلا يحق للأغنياء أن يحرموا شركاءهم من أموالهم: «إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم»[120].ولذلك كان للدولة الإسلامية -وبغية الحيلولة دون نماء الثروة وتكديسها، وإيجاد حالة من التوازن الاقتصادي- جباية الخمس والزكاة، أو وضع بعض المقررات والقوانين لأخذ جزء من أموال الأغنياء وصرفه على الفقراء والمحرومين بهدف القضاء على الفقر والحرمان.وقد قال الإمام الخميني (قدس سره) بهذا الصدد: «إن الإسلام يقر الملكية وذلك لأن قوانينه إنما تهذبها وتعدلها، فإذا ما امتثلت هذه القوانين لم يكن بوسع أَي فرد أن يقتني أراض شاسعة. فالملكية في الإسلام إنما تكون بالشكل الذي يجعل الجميع على مستوى واحد من المعيشة»[121].ونخلص مما سبق إلى أنّ القلق والهاجس في عدم تحقق العدالة ليس السبب فيه القوانين الإسلامية، بل بالعكس، التغاضي عن تطبيق القوانين الإسلامية قد يفرز تلك الحالة من القلق والخشية.2ـ دعم وحماية الفقراء والمحرومين:إنّ الفقر والحرمان الذي يسود طبقات المجتمع لا يمت بصلة إلى الإرادة والمشيئة الإلهية، بل ينشأ من جراء الظلم الذي يمارسه الأغنياء، وسرقتهم لأموال الفقراء والضعفاء.وقد جرت سيرة أنبياء الله وأوليائه على مواساة المساكين والضعفاء والمحرومين، فقد كان سيلمان (عليه السلام) يستفسر عن أَحوال الأغنياء ويقتفي آثار الفقراء ويجالسهم قائلاً: «إنّما أنا مسكين من هؤلاء المساكين»[122]. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة المعراج قائلاً له: «إياك ومجالسة الأغنياء»[123]. وخاطبه في قرآنه قائلاً: ?وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا?[124].فقد عاش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسمى صور الزهد طيلة حياته، وهكذا اقتفى أثره خليفته ووصيه علي بن أبي طالب (عليه السلام) الذي جعل عيشه أُسوة لأفقر الفقراء من أَفراد مجتمعه فكان يشاركهم في جشوبة العيش ومكاره الدهر[125].وهنا لابد من القول بأن دعم ومساندة الطبقة المحرومة إنما يعني اجتثاث جذور فقرها وحرمانها، لا الإبقاء عليه وإقرار التمايز الطبقي، ثم العمل على دعم تلك الطبقة وتوفير الحماية اللازمة لها.3ـ استرداد الأموال السليبة والمغتصبة:هناك فئات استغلت غياب الدولة فتمكنت من خلال بعض الأساليب غير المشروعة أن تحصل على ما تشاء من الأموال والثروة. والحق يقال: إنّ هذه الأموال الطائلة إنّما تعود للأُمة ولا بد من إعادتها إلى بيت المال.والتاريخ الإسلامي ينقل لنا صوراً خالدة عن هذه الظاهرة، لعل أبرزها ما حصل عند تسلم الإمام علي (عليه السلام) زمام أُمور المسلمين، فنراه ما إن تصدى لخلافة المسلمين حتى أَعلن صراحة أنّه سيسترجع كافّة الأموال التي استولى عليها غصبا، فقال: «وَ اللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوَّجَ بِهِ النِّسَاءُ ومُلِكَ بِهِ الإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً ومَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»[126]. 4ـ التوزيع العادل للثروات والإمكانات:لا شكّ أنّ المصادر والإمكانات الطبيعية والأموال العامة إنما تعود لكفة أَفراد المجتمع، والكل سواسية في استثمارها والاستفادة منها، وهذا لا يتنافى بالطبع وما يستحقه البعض من مقدار أكثر إذا ما سعى وجهد نفسه أَكثر؛ شريطة تهيئة الإمكانات والأرضية لمثل هذا السعي الأكثر للأفراد كافة. وهذا ما كانت عليه سيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد عمل الإمام علي (عليه السلام) بالمساواة في بيت المال وكان يقول: «والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق»[127].وحين جابهه البعض بالاعتراض استشهد بما كان يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلاً: «أعطيت كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعطي بالسوية ولم أَجعلها دولة بين الأغنياء»[128].وقال الإمام الصادق (عليه السلام) -بهذا الخصوص-: «أهل الإسلام هم أبناء الإسلام، أُسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أَحملهم كبني رجل واحد»[129].ومن هنا يتضح أنّ الفضائل الروحية والصفات المعنوية ليست مسوغاً لاستثمار بيت المال أكثر من الغير، لأنّ بيت المال ملك للجميع، ولا يمكن للسبق في الإسلام، والحضور في الجبهات وخوض غمار الجهاد، والورع والتقوى أن يكون مسوغاً لأخذ سهم أكثر من الآخرين من بيت المال، فضلاً عن بعض الأفراد الذين يرون لأنفسهم الحق في أَخذ ما يشاؤون من بيت المال على أنهم ينتسبون لفلان أو ينتمون للعائلة أو القبيلة الفلانية.وبالطبع فإنّ وظيفة الجميع لاسيما الحاكم الإسلامي -قبل غيره- إنّما تكمن في القضاء على النزعة الجاهلية القائمة على أساس الطبقية والتمييز العنصري الذي يسود المجتمع، وهذا هو الأسلوب الأفضل الذي يمكن على ضوئه تحقيق العدالة الاجتماعية.ولا فرق بين الأفراد الذين تسودهم تلك النزعات المذمومة سواء كانت متمثلة في تاجر ثري أو صاحب منصب حكومي، أو عالم ذي مكانة خاصة، أو سائر الطبقات الاجتماعية. فسوف لن يكتب لتحقيق العدالة الاجتماعية النجاح ما دام الثري يعتقد بأنه أكثر استحقاقاً من الآخرين بسبب ثروته وعناه، أو الوزير بسبب مسؤوليته في الدولة، أو بعض الأفراد الذين لهم بعض الانتماءات القبلية والأُسرية، دون طمعهم وسعيهم لاستثمار جهود الآخرين، وتحقيق أغراضهم ومآربهم.ووظيفة الحاكم الإسلامي إنّما تكمن في الوقوف سداً حصيناً منيعاً أمام هذه الرذيلة الأخلاقية - الاجتماعية المقيتة التي تعترض سبيل تطبيق العدالة.-------------------------------------------------------------------------------- * ترجمه إلى العربية: عبد الرحيم الحمراني.[1] لسان العرب 1: 436، الراغب، المفردات، مادة عَدَل، ترجمة وتحقيق غلام رضا خسروي الحسيني 2: 565، تهذيب اللغة 2: 218، مقاييس اللغة 4: 247، المحكم 2: 13.[2] مقاييس اللغة، ابن فارس 4: 246-247، مادة: عدل. [3] سورة الأنعام: 1. [4] جامع الشتات: 699، الشهيد في الذكرى: 230، مستمسك العروة الوثقى 1: 46، تحرير الوسيلة 1: 10. [5] جميل حليبا، الثقافة الفلسفية، ترجمة منوچهر صانعي دره بيدي: 460. [6] كليات الحقوق 1: 205، الحقوق الفطرية: 310. [7] تاريخ الفلسفة السياسية 1: 109. [8] الثقافة الفلسفية: 461 [9] مجمع البيان 1: 103. [10] شرح نهج البلاغة 18: 216 و 272. [11] المكاسب، رسالة العدالة: 326.[12] المصدر السابق 12: 253.[13] تفسير الميزان 6: 219.[14] دراسة مباني الاقتصاد الإسلامي: 16. [15] نهج البلاغة، الخطبة 37: 81، تحقيق الدكتور صبحي الصالح.[16] التنمية السياسية عن الإمام علي (عليه السلام)ع: 7.[17] عظماء الفلاسفة 1: 80.[18] هنري توماس، الوقائع الفلسفية الخالدة: 40.[19] المصدر السابق 43.[20] تاريخ الفلسفة السياسية 1: 109.[21] عظماء الفلاسفة 1: 298.[22] الوقائع الفلسفية الخالدة: 63.[23] عظماء الفلاسفة 2: 465.[24] الحقوق الفطرية: 359.[25] تاريخ الفلسفة في الاسلام: 655.[26] المصدر السابق: 814-815.[27] المصدر السابق: 683، وما بعدها.[28] المصدر السابق: 773.[29] تفسير الميزان2: الآية 213 من سورة البقرة 4: الآية 200 من سورة آل عمران.[30] ومنها كتاب الوحي والنبوة، التكامل الاجتماعي للإنسان، عشرون مقالة، الإسلام ومقتضيات الزمان العدل الإلهي.[31] سورة النحل: 90.[32] سورة ص: 26.[33] سورة المائدة: 8.[34] سورة الحديد: 25.[35] الميزان 19: 198.[36] سورة النساء: 135.[37] الحياة359: 6.[38] نهج البلاغة، الحكمة 437: 553، الدكتور صبحي الصالح.[39] دراسة في نهج البلاغة: 80.[40] سورة البقرة: 282، سورة المائدة 95.[41] سورة النساء 3 و 129.[42] سورة الأنعام: 152.[43] سورة النساء: 58.[44] سورة المائدة: 8.[45] غرر الحكم، الآمدي 1: 133، الرقم 495.[46] المصدر السابق: 11.[47] نهج البلاغة، الرسالة 53: 426. [48] غرر الحكم، الآمدي 1: 103. [49] مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمد بروين گنابادي 1: 65. [50] غرر الحكم، الآمدي 1: 103. [51] الإمام الخميني، ولاية الفقيه: 59. [52] سورة الحديد: 25. [53] الإمام الخميني، كتاب البيع 462: 2.[54] نهج البلاغة، الخطبة 33: 76، الدكتور صبحي الصالح.[55] المصدرالسابق، الخطبة 131: 189.[56] سورة الزمر: 9. [57] سورة المجادلة: 11. [58] سورة يوسف: 55. [59] نهج البلاغة، ترجمة فيض الاسلام، الخطبة 172. [60] الكافي 1: 542. [61] نهج البلاغة، الرسالة 5: 366، الدكتور صبحي الصالح. [62] بقاء الدولة وزوالها: 137. [63] غرر الحكم: 241. [64] نهج البلاغة، الحكمة 110-488، صبحي الصالح. [65] العلامة محمد تقي الجعفري، ترجمة وتفسير نهج البلاغة 3: 265. [66] سورة البقرة: 282. [67] ترجمة وتفسير نهج البلاغة 3: 285-290 باختصار. [68] محمد تقي نظر پور،القيم والتنمية: 27 - 28. [69] مهدي بناء رضوي، نظرة تحليلية للاقتصاد الإسلامي: 128. [70] اقتصادنا 2: 65.[71] سورة النحل: 90.[72] تفسير الأمثل 11: 367.[73] تفسير نور الثقلين 3: 78.[74] تفسير الأمثل 11: 372.[75] سورة الشورى: 15.[76] سورة الأعراف: 29.[77] سورة النساء: 135.[78] المذهب والنظام الاقتصادي الإسلامي: 57.[79] سورة الممتحنة: 8.[80] السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا: 303، ط- بيروت. [81] سورة فاطر: 15.[82] غرر الحكم ودرر الكلم، الآمدي.[83] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 3: 163.[84] المصدرالسابق 18: 185، بحار الأنوار 1: 94.[85] الحياة 4: 280. [86] المصدر السابق 282.[87] نهج الفصاحة، الكلام 252.[88] نهج البلاغة، الحكمة 319: 531، صبحي الصالح.[89] المصدر السابق، الحكمة 163: 500، صبحي الصالح.[90] الأنظمة الاقتصادية: 237.[91] سورة التوبة: 60.[92] سورة البقرة: 268.[93] نهج البلاغة، الخطبة 209: 324، صبحي الصالح.[94] بحارالأنوار 72: 29.[95] محمد رضا اليوسفي، كليات الاقتصاد الاسلامي: 63-68.[96] بحار الأنوار 73: 177 - 178.[97] فروع الكافي 5: 71.[98] بحار الأنوار 72: 63.[99] سورة الحشر: 7.[100] الأنظمة الاقتصادية: 237.[101] سورة التوبة.[102] سورة البقرة: 273. [103] سورة الذاريات: 19. [104] وسائل الشيعة 6: 184-185، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، الباب 28، ح3. [105] المصدر السابق: 178. [106] المصدر السابق: 201، الباب 41،ح2. [107] اقتصادنا: 303 [108] فلسفة حقوق الإنسان: 219، اقتصادنا: 706-707. [109] تفسير الميزان 20: 102-104. [110] سورة نوح: 13-14. [111] سورة التكاثر: 1. [112] تفسير الميزان 20: 495-496. [113] فرامرز رفيع پور، التنمية والتضاد: 283. [114] سورة التوبة: 34. [115] الشيخ الصدوق، علل الشرائع: 369. [116] سورة المعارج 24-25. [117] مستدرك الوسائل 11: 380. [118] وسائل الشيعة 4: 6، باب 1، مما تجب فيه الزكاة، ح6. [119] نهج البلاغة، الحكمة 320. [120] وسائل الشيعة 6: 150، باب4 من أبواب مستحقي الزكاة، ح4. [121] البحث عن السبيل في كلمات الإمام، الفصل الأول: 21. [122] بحار الأنوار 14: 83. [123] الديلمي، إرشاد القلوب: 201. [124] سورة الكهف: 28. [125] نهج البلاغة، الرسالة 45: 418، صبحي الصالح. [126] نهج البلاغة، الخطبة 15، للوقوف على التفاصيل راجع ترجمة وتفسير نهج البلاغة للعلامة محمد تقي الجعفري 3: 249 وما بعدها. [127] وسائل الشيعة 11: 81، باب 39، التسوية بين الناس، ح4. [128] الكافي 8: 60. [129] الحياة 6: 372.


 العتبة العلوية المقدسة
العتبة العلوية المقدسة العتبة الحسينية المقدسة
العتبة الحسينية المقدسة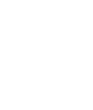 العتبة العباسية المقدسة
العتبة العباسية المقدسة العتبة الرضوية المقدسة
العتبة الرضوية المقدسة العتبة العسكرية المقدسة
العتبة العسكرية المقدسة