القرآن منطلق رسالة النهضة

لقد أضحى الذكر الحكيم عبر المدى التاريخي المتصاعد المنهج الراقي والأصيل الذي يحقق للبشرية المقاصد والأهداف الإنسانية النبيلة، وظل وما زال يجدد معالمها ومفاهيمها حسب مقتضيات المراحل الزمنية والمكانية، ولقد أرسى أرقى المناهج والرؤى لاستنباط الحقائق الكبرى التي تحيط بزوايا ومكونات الواقع الإنساني وتستوعب كافة احتياجاته ومطالبه الحساسة، ليكون بمثابة المرآة التي تعكس الطموحات والأفكار لإنماء حراك الواقع ورفد نهضته وتقدمه.فمنذ إطلالته الأولى على البشرية مهَّد لغرس نواة منظومة المعارف والعلوم التي تتشعب من ظلالها الوارف أفكار وثقافات النهضة والتقدم لمجالات الحياة وعمارتها، وفق نظم وقوانين محكمة ومتناسقة، لتنتشل الإنسانية من أسوار البلادة والانقياد لأمواج الثقافات والأفكار التي تؤدي بمكوناتها ومقدّراتها نحو الغياب والضياع، فمنذ الوهلة الأولى لمقدمه أرسى أصول معالمه العلمية لرفد الواقع بالمستلزمات الضرورية التي تلامس الطموحات والأهداف، وهي لا تناقش المفردات الجزئية الطارئة على المسرح الحياتي، بل تتحدث عن الكليات والمرتكزات التي تنضوي إليها سائر المستحدثات والمستجدات لتلبي للواقع احتياجاته وتحقق مقاصده، قال تعالى: ?وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ?[1]. وقال تعالى:?إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً?[2].وليس من ريب أن الزخم الهائل من التوجيه والإرشاد القرآني لم يأت تدوينه لالتماس التبرك والاستشفاع بنوره الميمون فحسب، إنما لتتحول كل مفردة من مفرداته إلى حركة فاعلة تتجسد بكافة مفاهيمها ومعالمها على حراك النسيج الإنساني، لترفد مساعيه الخيِّرة بالبصائر والرؤى، فالحقائق القرآنية بكافة موضوعاتها ومفرداتها تشكل المدخل الأساسي لفقه المعارف والعلوم التي تطلق المسيرة الإنسانية نحو البناء والتعمير، وتؤهل الواقع البشري لاكتشاف العناصر المفقودة والرموز الغائبة لتحقيق الكرامة والعدل والحرية بكافة لوازمها ومكوناتها، فضلاً عن مناخات الأمن والاستقرار التي ظلت تفتقدها الحياة الإنسانية، ولم تتحقق حتى حاضرنا الراهن رغم ادِّعاء النظم المطالبة بتحقيقها والالتزام بمضامينها.وثمة حقيقة ناصعة أن الفكر القرآني لم يأت ليصبغ مساحات الحياة بملامح الإيمان الراقية، والتفاني من أجل إحياء شعائره في أرجاء المعمورة، كي تتهاوى ألوية الشرك والإلحاد من كافة البقاع ولا يبقى إلا شعار التوحيد، إنه لا يعزو لذلك فحسب، بل جاءت منطلقاته الإيمانية متزامنة برفد الواقع بالرؤى والتصورات التي تطلق مساعي الإنسان ليكرّس جهده لتحقيق أرقى القيم والمبادئ التي تحقق المكاسب والإنجازات في طور البناء والتعمير، وكان النداء البارز الداعم للحراك الإنساني وتطوير مجالاته المتنوعة، ليتصدر المكانة المرموقة في السلم الحضاري، وهو ما يلمس من قوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ?[3].إن هذه الدعوة احتضنت منذ انطلاقتها المباركة كمًّا هائلاً من مفردات الإصلاح والتغيير لاستنقاذ الواقع البشري من أزماته ورهاناته الحرجة، وبما أن البشرية كانت تسير على مفترق طرق متشعبة، وتتجاذبها التيارات الاستكبارية على مرّ الزمان والمكان، لسحق كل قيمة إنسانية خلّاقة تلبي للبشرية مطالبها ومقاصدها، كان نداء الإصلاح ينتصر للمعاني والمفاهيم الإنسانية، ليجدد الصياغة التي تقوم عليها العلاقة بين الإنسان وما حوله من أشياء، وتضع له القوانين والنظم التي تؤسس الواقع الأفضل لتكافل القدرات والإمكانات ضمن صعيد مشترك، ولم تكتف بالحض على ترسيخ مناهج الدعوة للانسجام والتعاطي مع الحراك الإصلاحي، إنما شجبت كل لون من العبث والتشويه للتلاعب بمصير النسيج الإنساني، يقول تعالى: ?وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ?[4].ولأن الفكر القرآني لم يغفل المجريات والأحداث التي تتكبدها البشرية طوال الحقب التاريخية، فإن خطابه لامس أمهات القضايا والأزمات التي تتمحور حولها الظواهر والعلل المستعصية، لا لكي يكشف عن مدى المأساوية، وألوان القهر والاستبداد، وما يساورها من طرق الغي والضلال، إنما ليثري الواقع البشري بالحقائق الكبرى التي تطلق الحراك الإنساني من وهدة ضياعه وغيابه لتحقيق الكرامة والحرية في كافة مجالاته وأصعدته الحياتية، فهي حركة ونهضة واعدة للانتفاض على الظلم والقهر والأمية والتبلد، والتفاني للخلاص من التبعية لتقاليدها وأعرافها البالية، ولا غرو أنها بمثابة النواة المباركة التي تطلق الحراك نحو التصحيح والتجديد لتحقيق المقاصد المنشودة، وقد بين الباري عز وجل معالم التركيبة التي تخطو بوعي للخروج من مصائرها القاتمة: ?الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ?[5].ذلك الاتباع الراشد استطاع أن يحط على مرسى الحقيقة لتندمل جراحه المتكلسة، كل ذلك حين كرّس مساعيه الحثيثة لنفض غبار الجاهلية والانعتاق من أعبائها ورواسبها، لتتهيأ له الأرضية الخصبة التي تؤهله للبناء والنمو وفق تصور وبصيرة راقية، ودون الالتفات لتلك البؤر والثقوب السائدة والاعتراض عليها سيمتد البقاء لأوزار الجاهلية المتبلدة إلى ما لا نهاية، فتلك الوثبة الخلّاقة غيَّرت وأصلحت الكثير من الأوضاع المعاشة، وقفزت بالنوع الإنساني إلى التكامل نحو المقاصد والأهداف، ومن هذا المنطلق فإن الأجيال متى ما استفاقت من سباتها وغفلتها وتحملت مسؤولياتها للخلاص من ثقافتها المغشوشة وموروثاتها المتقاعسة فإنها ستحقق الأمن والاستقرار والحرية والكرامة.انتفاضة المعرفة والبصيرة:الركيزة الأساس لكل نهضة حضارية في الوجود لا تقوم على الجهل والبلادة والتقاعس والدعة، إنما المعرفة والبصيرة الثاقبة مبعث كل أمة ونهضة ومأسسة منطلقاتها، فلا تجد حضارة واعدة في أرجاء المعمورة وليدة الفراغ والعجز، ولا تجد نهضة إنسانية عملاقة نتاج استئثار البلادة والتقاعس والهروب عن تحمل المهام الجسام، بل إثارة مكونات المعارف والعلوم وانتهاز الفرص للمثابرة بالعمل الدؤوب منشأ حركات التحضر والتقدم في رحاب الكون الفسيح، فكما أن هناك ملازمة بين الجهل والضياع وما تتكبده البشرية من دمار، وانتشار للعلل والظواهر الوبائية الجالبة للهلاك والدمار، فكذلك العلوم والمعارف تشق طريقاً للتقدم والتطور والازدهار، وأساس كل صحوة ونهضة في مجالات الحراك الإنساني، وفي خضم هذا الصعيد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) دعوته لكسب العلوم والمعارف لمدى أهميته وما يتركه من أثر ملموس على واقع الحياة، فيقول (عليه السلام): «اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة»[6]. وإذا كانت وظائف الحياة ومهامها الملحة بحاجة إلى عتاد ومداد تستند إليه لإنجاز أكبر قدر من المكاسب وتحقيق النتائج المتنوعة، فإن الثروة الحقيقة التي ينبغي توفيرها بكل حرص وتفانٍ هي اكتساب أكبر قدر من العلوم والمعارف، لتصبح الأمة ذات كفاءة عالية تؤهلها لاحتضان بنود النهضة والتقدم، وترفد حراكها لتفجير القدرات والإمكانيات الدفينة، ولذا يقول الإمام علي (عليه السلام): «إن العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، وقوة الأبدان من الضعف»[7].ولقد تميّزت رسالة الإسلام عن سائر الأمم والديانات المختلفة بما كانت تعيشه وتنبعث منه من عمق حضاري، ولقد كان هذا التميز متجلياً منذ نشء حركة الدعوة، وأروع معاني هذا العمق الحضاري البدء بالكلمة والدعوة إلى نهضة العلم والتفقه في شتى ميادين المعرفة، ومما أدركه الرعيل الأول من الأجيال المسلمة مدى أهمية هذا العنصر الأساسي في تأسيس مكونات الأمة ونهضتها، إذ إن الأمم لا تتقدم إلا بما تمتلك من ذخائر العلوم والمعارف، قال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ?[8].وثمة حقيقة لا ينبغي إهمالها وتجاهلها هي أن الثروة القرآنية مادة خصبة لا تهمش بحال من الأحوال وليس لنا أن نقصيها عن مزاولة مهامها ووظائفها في ميادين الحياة، لا لأنها تفرض أفكارها ومعارفها للاتباع قسراً، بل لاحتضانها الأصالة الفكرية والعقدية التي لا يساورها زيف وزور، ?ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ?[9]. وعلى مرور القرون المتطاولة وتشعب وسائل العلوم والمعارف بثرائها الهائل، لم يأت ما ينقض حقائقها ويخالف ما تنبئ عنه، بل ظل البريق القرآني طوال عهوده الكتاب الذي يقرأ ملامح واقع الحياة بمنظار لا تسجل عليه مثلبة، ولا تتزلزل قيمه ومبادئه إزاء المتغيرات والمستجدات على مدى الزمان والمكان، ?لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ?[10]. ورغم ما يحيط به من حقائق ومفاهيم راقية لا نظير لها تتجلى على مسارح الحياة ومدارجها، فهو بمثابة المختبر لبناء الأجيال الصالحة وإنماء حراكها، وشريان الحياة الزاخر بجوهر الكنوز والمآثر التي تعرج بالإنسان نحو الحضارة والتقدم.ولا غرو أن التخلف الذي أحدث انقلاباً مغايراً في بنية الأمة ومكوناتها كان منشؤه تغييب هذه الحقائق وطمس معالمها الأصيلة، ومغادرتها مع مرور الزمن أدراج المسرح الحياتي، فبعد أن كان الاجتهاد والمثابرة على الاستزادة والكسب المعرفي وقود هذه الأمة وعتادها للانطلاق والتقدم في الركب الحضاري، باتت منشغلة بهموم ثانوية لا تمت بصلة إلى تطورها وتقدمها، لا لأن منابعها الفكرية نضبت وتلاشت، إنما أصبح هذا الاهتمام يتخذ جوانب أخرى لا تلامس الرهانات الحساسة التي تواكب مجريات الواقع، وبيد أن التاريخ المشرق للأمة حافل بالإسهامات العلمية والمعرفية في كافة الحقول والميادين، وما وصل من تجارب رائدة صالحة لتدشين نواة الانبعاث بركب التقدم الحضاري، وتأهيل الواقع واندماجه بمكونات النهضة الإصلاحية ولوازمها، إلا أن عصورنا الراهنة بما يتوافر لديها من عناصر حديثة تخدم قضاياها وهمومها، أضحت بعيدة عن رهانات الواقع وما ينبغي استحضاره من صناعة فكرية ومعرفية لمواجهة المجريات والأحداث المواكبة، في الوقت الذي يتجسد هذا الاهتمام عند الآخر المغاير فيستأثر بكل ما لديه لتجديد أفكاره ومنطلقاته لتحقيق أكبر قدر من الرقي والتقدم.ناهيك عن أنه أضحت الصناعة الفكرية والمعرفية لدى المعسكرات الغربية والشرقية لا تتوقف على منتجها ومؤسسها، ولو كانت كذلك لتضاءلت فرص النجاح لها ولم يكن لها الصدى الواسع في الانتشار، غير أن المؤسسات التبشيرية والشبكات الإعلامية الكبرى التي تقف لتصدير المنتج الثقافي تمارس دوراً بارزاً في الترويج لتلك الأفكار، هذا لا يعني أن المحتوى ركيك ويشوبه ضعف الصياغة، إنما الإشارة إلى الدور الذي تقوم به تلك الدوائر لتصنع من الأفكار والمنتج الثقافي حالة متميزة تقوم على حراك الرأي العام للتوجه نحو المستنتج وتداول أفكاره في فضاء طلق، ولا غرو أنه قد تتوافر من الإنتاجات الثقافية والأدبية ما يضاهي تلك الإصدارات ويتفوق عليها، إلا أن تلك الإنتاجيات لها طابع خاص عند تلك المعسكرات الغربية والشرقية، ولذلك فإن أقل ما يطبع قد يصل إلى عشرة آلاف، أما بالنسبة لعالمنا العربي والإسلامي فلا تجد هذا الصدى والانتشار، وإذا كان هناك صخب إعلامي فهو لتسويق أقلام مأجورة، وصفحات ماجنة مغشوشة لا تصلح إلا للتبعية والانهزام، أما ما يخص المنتج الثقافي والمعرفي الحر والمستقل فإنه في أقل التقادير لا يتجاوز ثلاثة آلاف نسخة، والتسويق معتمد على التوفيق، هذا فضلاً عن المعاناة الشاقة التي يلقاها صاحب الفكرة حيث لا يتاح له المناخ الملائم لطرح مرئياته واستنتاجاته في فضاء تسوده الحرية والانفتاح، وليس لها الحظ في التداول والمطارحة ما يشغل الساحة ويحركها نحو الطابع الثقافي والمعرفي. روافد التحرير من التبعية:من بين المهام التي انبعث بها الفكر القرآني وسعى لتكريس معالمها ومفاهيمها عند المجتمعات الإنسانية، الدعوة لتحرير العقل البشري من سباته وضياعه؛ لعتقه من الأغلال والقيود التي كُبِّل بها طوال الحقب المترامية في عرصات التاريخ، إذ لم تكن المشكلة المؤرقة التي عانى منها في المرتبة الأولى مرتبطة بأزماته الاقتصادية أو الاختناقات الاجتماعية والسياسية فحسب، إنما هي أزمة استهدفت شل قدرات العقل وتعطيل روافده الخيرة، ولذا كان الهدف ينبعث نحو استرداد الحقوق إلى مكانتها الطبيعية، إذ أشد ما تخشاه أن يسوغ للتلاعب بالمصير الإنساني واستباحة مكانتها لتغييب قيمة العقل ووظائفه الراقية. وربما كان السبب الحقيقي وراء غياب دور العقل وإعاقته عن النمو عند جل المجتمعات الإنسانية، أن كثيراً من الصلاحيات والخصائص تسلب منه، ولا تتاح له الفرصة الكافية لانطلاقة حركته الفكرية والمعرفية، وهو المشهد الذي نلمسه لحال العقل المسلم والعربي الذي بات مشوهاً ومغيباً تتلاعب به النظم الفاسدة كيف تشاء، وتحجب عنه الحقائق والرؤى مهما كان لونها وأثرها، وهو ما ساعد على إعاقته وتضييع مكانته ليألف الضياع والهوان، وإذا كان الاجتهاد فيما مضى من دواعي النهضة وتحقيق الإنجازات المتتالية، فإنه أضحى يكتنز أرصدة الجهل والتبلد في ظل تفتح ثورة العلوم والمعارف، بعكس الدوائر الغربية التي هيأت الوسائل والإمكانات الهائلة، وكرّست جهودها لإزالة الحواجز والعوائق لتمهيد أرضية الانبعاث والتقدم. إن الإلغاء لوظائف العقل ومهامه من أخطر ما تصاب به المجتمعات ليس لأنه يُكرّس الأمية والتبلُّد، ويدفع الواقع إلى التقهقر والتخلف فحسب، إنما هو تعطيل للحقائق والبصائر ويقود الواقع إلى الهاوية، ثم ما يقع من كوارث ونكبات ومآسٍ ليس إلا شيءٌ قليلٌ مما ينتج عن مناهج مغايرة إزاء الحقوق الإنسانية، ولا غرو أن ذلك لا يبرر إعفاء الإنسان من مسؤولياته الملقاة على عاتقه، وما ينبغي أن يتحصل عليه لإبراز كفاءته وقدراته، فبرغم الوثوق بحقيقة ما يساوره من ضغوط مواجه لنهضته وانطلاقته، إلا أنه يتحمل قسطاً مما يتكبده من مجريات وأحداث، فحديث القرآن لم يُسهب في وضع الحلول ليعطل الفكر الإنساني عن السعي والمثابرة، والبحث عن الخارطة التي يسلكها الإنسان للخروج من الأزمات المريرة، فرغم أن الأنبياء والرسل (عليهم السلام) امتلكوا سلاح الإعجاز الخارق لنواميس الطبيعة وأنظمة الكون، التي تفوق قدرات البشر وإمكاناتهم، ولها أن تحقق الانتصارات الكبرى بمنظور المقاييس والمعايير الحياتية، إلا أن ذلك لم يحدث إلا ضمن مجالات خاصة، وفي خضم ظروف قهرية تستلزم استخدام تلك الوسائل، ذلك أنهم لم يبعثوا لتأصيل حالة الاستبداد والتسلط والقهر، إنما كانت رسالتهم تستنهض أدوات العقل لتفجير طاقاته المكبوتة ولإثراء الواقع بالفكر الصادق الذي يحقق الهداية والرشاد، ويبعد الواقع عن الغي والفساد، كي لا تبقى الأجيال تجتر التخلف جيلاً بعد جيل دون اكتراث لما يحدث لها. وعند قراءة هذا الشأن من خلال النداء القرآني للبصائر والأفئدة يستشف من ظلاله المبارك متابعته الدائمة للمحطة المركزية التي تتسبب باستيطان الرواسب والتبعات التي تنتشر بين البشر دون رقيب وحسيب، لا ليكشف عن مدى القصور والتيه والتخبط لمسيرة العقل البشري قديماً وحديثاً فحسب، بل ليطالبه بالكسب والإنجاز في كافة ميادينه ومجالاته الحياتية، ولا يحتاج الأمر لبذل جهدٍ من البحث والتنقيب لإدراك حقيقة ذلك، فالخطاب في غاية الوضوح، واسترساله التصويري لمحتويات الكون الفسيح مناداة صريحة لإثارة العقل وتفتحه على الحقائق المتجلية في رحاب الكون الرحب، قال تعالى: ?إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ?[11]. إن تسليط الضوء للإبحار بالفكر نحو الآفاق رافد لتجديد النظرة وتصحيح المنطلقات، لتتشكل النواة الخصبة التي يرتكز عليها الفكر البشري في تتبع الرؤى والبصائر التي تنتشل الإنسان من براثن الانحطاط والضياع، ولذا فإن الآيات الكريمة توالت بتذكيرها للإنسان كي يختبر مواقفه بمجهر الفكر المتفتح على آفاق الحقائق المنتشرة في أرجاء الوجود، قال تعالى: ?كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ?[12]. وقال تعالى: ?وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ?[13]. ولا غرو أن العناية والإحاطة الشاملة بأدوات الفكر وآلياته تجلّت كسمة بارزة في المفردات القرآنية، وترد الأهمية القصوى لما يعترض طريق الفكر من عوائق هائلة تحجب عنه كشف الحقائق والرؤى، ورغم الشحذ الدائم لوقف مسلسل الضياع طوال العهود التاريخية، وإطلاق إشارات التحذير بكل ما يحتاجه من تصورات وبراهين، إلا أن ما يتسلل من أمواج الثقافات والأفكار المغايرة يختطف المساعي والجهود بين فينة وأخرى لتلقي بالإنسان في أنفاق التيه والتخبط، ليكون فريسة سهلة بين يدي تجار وسماسرة النظم الفاسدة تتقاذفه كيفما تملي عليها مقاصدها ومصالحها، وما يواكبه الفكر البشري في كل زمان ومكان يساير ذلك الحال، وفي ظل ظروفنا الراهنة وما يحاك بخفاء من قبل الدوائر والنظم الاستكبارية وأتباعها، لانتهاك الحقوق الإنسانية والتلاعب بمكوناتها وخصائصها بمسميات وعناوين مختلفة، ليجرد الإنسان المستضعف من هويته وتراثه، كيما تتقلص مكاسبه وإنجازاته فيما يُغيِّر ويُصلح من واقعه المزري، ولا غرو أن ذلك يستدعي استحضار المختزل الموروث لاستنقاذ الواقع من أزماته المريرة، وشحذ منطلقاته بآفاق الفكر الأصيل. إن فاتورة الضرائب الباهظة التي تدفعها البشرية من تضحياتها ودمائها طوال العهود البائدة لم تُنتهك لتحقيق مصلحة إنسانية نبيلة، تقوم على الشراكة وتبادل الاستحقاقات في الأدوار والوظائف الحياتية، أو لتحقيق مساحة أكبر من الحرية والأمن والاستقرار، إنما كان تسخيرها لغايات محدودة لا تكترث لقيمة إنسانية كريمة، فهذا الإسراف المتعاقب في زهق أرواح الملايين من البشر لا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون لإنجاز مهام علمية تتورط بتبعاتها البشرية بشتى أعراقها وألوانها، ورغم أن جلها قد يسهم في تحقيق مصالح مشتركة تعود منافعها على الجميع، إلا أن هناك ما يصوب لسحق وانتهاك كل قيمة إنسانية بديعة، ذلك حينما يتبين طغيان التكنولوجيا الحديثة التي لا يقتصر تهديدها على نشر الرعب الصامت لمناطق نائية في بقاع المعمورة، إنما فيما يستبطن من إضرار واعتداء صارخ ضد كل ما هو قائم على وجه البسيطة. وكافة ما يستخدم من غوغائية تعسفية هي دعوة صريحة لتكريس نظم التبعية وشل قدرات الشعوب عن التحرر والانعتاق من أسوار النظم الاستكبارية. من هذا المنطلق فإن المسؤولية الملقاة على كافة النخب والشرائح الاجتماعية لا تقصر على مزاولة بعض المهام الهامشية والتغاضي عن أمور جوهرية، إنما هي بحاجة ماسة إلى ملامسة الأزمات المزمنة التي تعيشها مجتمعات الأمة. وما ينبغي الإشارة إليه أن ما يهدر من ثروات طائلة وميزانيات لا حصر لها في أقطار وطننا العربي والمسلم، وما يستنزف من قدراتها وإمكاناتها على قضايا جانبية لا تقدم من شأن الأمة ومشاريعها التنموية، فضلاً عن الاهتمامات القشرية المبالغ في المزايدة على إنمائها، لتتضاعف الانكسارات والهزائم عليها دون اكتراث والتفات إلى ما يُتسابق عليه في عصورنا الراهنة وما تعترضنا من رهانات حرجة، إذ إن الأمم الإنسانية تخوض معركة حاسمة نحو البناء والإنماء لكسب أكبر قدر ممكن من الإنجازات والاكتشافات وعالمنا لا يزال يغط في سباته، فلو فرغ جزء يسير من تلك الإنفاقات الهائلة لتشييد المعاهد والصروح العلمية لاستثمارها في بناء العقول والاهتمام بالقدرات لما كانت أوضاعنا على ما هي عليه من تخلف وتبعية لاستيراد أبسط وأتفه الموارد، علماً أن رسالة ديننا الحنيف لم تُغفل تلك الجوانب، بل كان حرصها الدائم الاهتمام لتلك المسارات التي تزيد من فاعليتها ونشاطها لتحقيق المكاسب والإنجازات على كافة الأصعدة والميادين، وشجبت منذ نشأتها الأولى جميع ألوان الجهل والتبلّد والتقاعس الذي يكرّس فيها التخلف والتقهقر. مجتمعات إنسانية متجانسة:المجتمعات الإنسانية على سطح كوكبنا المعمور تتكون من طبقات متعددة ومتنوعة في منطلقاتها وأفكارها، وهكذا بالنسبة لمستوياتها وتوجهاتها، ورغم التباين والاختلاف في المستويات والمسارات، والمهن والوظائف، إلا أن ذلك لم يؤسس لطغيان جهة ضد أخرى، أو انتهاك لخصائص وحقوق أمة ضد أمة، إنما منشأ التعدد والتنوع جاء ليؤسس دعامة راسخة لرفد مسيرة البناء والإنماء في نهضة واقع البشرية. وفي ظل النزاعات المحمومة بين الأمم البشرية وما يقع عليها من كوارث ومآسٍ تجلب لها الدمار والهلاك، وتُقوِّض أمنها واستقرارها، فضلاً عن الخسائر الهائلة التي مُنيت بها طوال العهود التاريخية المنصرمة فخلَّفت لها تركة متخمة بالانتكاسات المتعاقبة، ومروراً بالتراكمات والترسبات المتكلسة التي ظلت ولا زالت تفرض قوانين وشرائع تنصب حواجزَ عائقةً بين المجتمعات الإنسانية، لتتصاعد وتيرة المقت والكراهية في طبيعة نظم العلاقات القائمة، تنبعث الصياغة القرآنية لتؤسس الرؤية الأصيلة لتعيد الذاكرة إلى قراءة الحقائق بمنظار ثاقب يجدد شبكة العلاقة بين الأمم بما تملك من أفكار وحضارات، وإذا أصاب الذاكرة عطوب نتيجة الأحداث والمجريات المتوالية عليها، فإن الفكر القرآني يدشن لعلاقة وطيدة بين كافة المجتمعات الإنسانية باختلاف مشاربهم وأعراقهم، ومن خلال مضامين الخطاب الهادئ والمتسامح يأتي التأكيد على أن البشرية تنضوي بكافة أعراقها ولغاتها إلى أسرة واحدة، لينشأ من خلالها التنوع والتعدد الذي يضفي التجانس والتكاتف على حراك الواقع الإنساني، من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتطور فيما يُكتشف من انجازات ومكاسب على مسرح الحياة، قال تعالى: ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ?[14].ورغم أن الآيات القرآنية سلَّطت الضوء على حقيقة الاختلاف السُّنَني بين طوائف البشر، وما يستوجب ذلك من تعدد وتنوع في الوظائف والمهام، فضلاً عما يساورها من تغاير عقدي وفكري يُفضي إلى التباين، قال تعالى: ?وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ?[15]. غير أن ذلك لم يكن مسوغاً لنشوب النزاعات والصدامات بين الأمم الإنسانية لتلقي بمقدراتها وجهودها إلى الضياع والتشتت، إنما لتتعارف وتتواصل الأفكار والثقافات ضمن مسارات متوافقة ومتجانسة لتشكّل نواة مشتركة في التبادل المعرفي وتمرير وسائلها وآلياتها بتسامح ومحبة واحترام، دون عرقلة ذلك بعقد وهواجس مصطنعة تؤسس للصدام والاحتراب بين القنوات الإنسانية المتشعبة، التي ظلّت ولا زالت النزعة المحمومة الذي تستوطنها أجندة القوى المتصدرة حضاريًّا ومعرفيًّا، في قبضها على وسائل العلم والمعرفة والتقدم، وحجبها عن الانتشار والتداول بين الأمم الإنسانية. ولا ريب في أن معالم الدين ومفاهيمه الأصيلة كانت التجسيد الحقيقي لحفظ الخصائص والحقوق في تشكيل الخارطة لأسس العلاقة المشتركة بين التنوعات المتعددة، التي لا تقوم على حفظ نسيج دون آخر، إنما حقوق مشتركة لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها والتعدي على مبادئها وقيمها، فكما أن للمسلم الحصانة الكاملة في الحقوق والخصائص، فكذلك المغاير يحظى بقسط وافر لحماية حقوقه وخصائصه، وفيما ينبغي أن يتبادل من احترام وتقدير وتسامح في مسارات التعايش المشترك، وقد ورد في الحديث أن الإمام الصادق (عليه السلام) قال لبعض أصحابه: «ما فعل غريمك؟ قال: ذاك ابن الفاعلة؟ فنظر إليه أبو عبدالله (عليه السلام) نظراً شديداً، فقال الرجل: «جعلت فداك إنه مجوسي نكح أخته، قال (عليه السلام): أوليس ذلك من دينه»[16]. وفي حديث آخر، أن رجلاً سبَّ مجوسيًّا بحضرة الإمام الصادق (عليه السلام) فزجره الإمام (عليه السلام) ونهاه، فقال له الرجل: إنه تزوج بأمه؟ فقال: أما علمت إن ذلك عندهم النكاح؟»[17]. إن منظومة الأفكار الدينية بما تحتضن من معارف وقيم لم تسع بحال من الأحوال إلى تحريض وتعبئة المجتمعات ودفعها في أتون الصدامات والاحترابات الدامية، بل على العكس من ذلك فقد أصَّلت لإنماء قيم التسامح والتعايش في ظل نسيج اجتماعي متعدد الثقافات والأعراق، لتكون المدخل الرئيسي للخروج من أنفاق الأزمات المستعصية، ورغم ما يتجلى من حقائق وبصائر تجاه قيم الدين ومبادئه الراسخة، إلا أنه لم يقسر الآخرين على الانقياد والاندماج بوسائل القهر والاستبداد، إنما على أسس التسامح والحوار الخصب، قال تعالى: ?وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ?[18].نواة التربية الصالحة:تسامت حكمة الدين ومبادئه في التعامل مع الإنسان فانبعثت مساعيه الحثيثة لتهيئة الوسائل والآليات التي تقوم حياة البشر وتصلح أحوالهم، لا اقتصاراً على ما يقع من مجريات وأحداث على المسرح الإنساني، إنما انطلاقاً مما تصبو إليه رسالة الدين من مقاصد وأهدف، ورغم أنها تنبعث لتحقيق ركائز العدل والحرية والأمن والاستقرار للبشرية كافة، إلا أن ذلك لم يكن الغاية فحسب، بل هو أعمق من ذلك بكثير، ولعل من جملة ذلك أنها تطلق في الإنسان التطلع والطموح، وتسلحه بأرقى المبادئ والقيم لتتولد لديه الكفاءة والتمييز لشق طريقه الإصلاحي في مضمار الحراك الحياتي.ولقد حرصت رسالة الدعوة منذ نشأتها على صناعة المناخيات الصحية الملائمة لاستنبات الأفكار والرؤى الواعدة في سائر مرافق الحياة الاجتماعية، وانطلقت مساعيها الحميدة لتنقية الأجواء وتطهيرها من الرواسب والتبعات المضرة بشبكة العلاقات الاجتماعية، ومن خلال توجيهاتها وإرشاداتها الدائمة سعت لغرس النواة الصالحة في أرضية المجتمع كي لا ينسجم أو يتعاطى مع الثقافات والأفكار الهدامة أو يميل إليها، فلم تسوغ بأي حال من الأحوال مهادنة الظلم والاستبداد السياسي والاقتصادي والعقدي، أو تدفع لإنماء وبناء حالة من العدوانية المقيتة، لتصطبغ شخصية المجتمع بالحقد والكراهية، فمنذ الوهلة الأولى لنشأتها نفت عنه تلك التوجهات والميولات التي لا تتوافق مع قيمه ومبادئه ومنطلقاته الخلّاقة، وجاءت هذه الدعوة لتؤسس:1: المنطلق الصالح:الذي ينبعث نحو بناء وإنماء مشروع الإصلاح في الحياة، ومن خلال قراءة هذا البعد في التوجيه القرآني تلمس مدى عمق هذا المنطلق في بناء حراك الأمة والمجتمع، الذي تقوم ركائزه على أسس الصلاح والإصلاح، فبرغم الدعوة المتكررة لتنشيط دوائر العمل وما له من أهمية راقية في طور التقدم والكسب لتحقيق الغايات والمقاصد، إلا أنه مع مطالبته الحثيثة لتجسيد الحراك والنشاط على كافة الأصعدة والمجالات المهنية والعلمية فإنه يقرن ذلك بالصلاح، ليس لأنه لا يكترث للنتائج إنما لاهتمامه بالجوهر الصالح في تحقيق المقاصد والأهداف، قال تعالى: ?الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ?[19]. وقال تعالى: ?إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً?[20]. 2: الأفق الرحب: الذي لا ينطلق في غمار الحياة من زوايا ضيقة وأفكار ومفاهيم متبلدة لا يمكنها أن تتعايش وتتأقلم إلا ضمن نطاقات إقليمية أو فئوية محدودة، وإنما هي نظرة شاملة ومتفتحة على نافذة الحياة، تستوعب كل ما حولها من أشياء، وترفد بعطائها الاستزادة والإفادة لكافة التنوعات البشرية، قال تعالى: ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ?[21]. وقال تعالى: ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ?[22]. ومن هذا المنطلق فإن المعيارية الحقيقية في تقييم الشخصية البشرية هو ما يحققه من إنتاج صالح تعود منفعته لتقدم الحراك الإنساني مع اختلاف الهوية والانتماء، قال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ?[23].3: الإيمان بالحقائق:من مزايا المجتمعات المتقدمة أنها لا تنقاد للخرافات والأساطير والثقافات القشرية المتبلدة، ولا تُذعن للهواجس والوساوس البلهاء، بل إنها تعيش الواقع حسب المعطيات والحقائق التي تجسد ملامح الفكر والرؤى التي تطلق القدرات والإمكانات لتحقيق أرقى النتائج والمكاسب، وترفد مساعيها بمزيد من الاستزادة والتقدم للوصول إلى أرقى المقامات الرفيعة، أما المجتمعات المتخلفة فتتجلى مشاهد التقاعس من خلال اهتماماتها للأمور القشرية والهامشية، والمبالغة المفرطة في مدى الرعاية والاهتمام لوسائلها وأدواتها، لتصل إلى حد التمسك والاعتقاد بفوائدها ونتائجها، فضلاً عما تحظى به من قناعة وثقة راسخة، وفي المقابل يتجلى النفور والانزواء عن تطبيق الحقائق وما تحتضن من رصيد خصب لإصلاح قضايا المجتمع وردم مثالبه ونواقصه.وفي خضم انقلاب المفاهيم وتبدل المعايير في منظومة السلوك التربوي، ليصبح المغاير بفعل المؤثرات والمساحيق التجميلية حق من الواجب اتِّباعه وعدم مخالفته، وربما يُعاقب على رفضه وتركه، وتُشوَّه آيات الحقائق ويُتلاعب بقيمها ومبادئها، ليُسلب منها جميع الصلاحيات، لتتحول بمرور الزمن إلى ظواهر منبوذة لا ترقى إلى فكر المجتمع ومشهده الثقافي، في ظل ذلك الصخب تنبثق حقائق الذكر الحكيم بعتادها العلمي والمعرفي لتُحلِّق بآفاق الفكر الإنساني للتخلص من التبعات والأفكار المناقضة، لتتحقق الكرامة والحرية للبشرية كافة، قال تعالى: ?وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ?[24]. إن هذه المعرفة لا تعتمد أساليب القهر والقسر في فرض مشاريعها ومناهجها المعرفية، إنما هذه المطارحات تستنهض أدوات الفكر لانتخاب واختيار الأفضل، عن طريق عرض المختلف والموافق بأسلوب علمي راقٍ، لتتم عملية الاستنتاج والاستنباط ضمن قنوات متفتحة ومستنيرة تقود إلى منابع الحقيقة الراقية.خاتمة:ما يمليه علينا الفكر القرآني من حقائق ومفاهيم لا يربطنا بمساحات ضيقة محدودة، ولا يأخذ بألبابنا ليلفت أنظارنا لاكتشافات آنية، إنما هو امتداد لحقائق متجددة ودائمة، لا لأنه يواكب حراك التطور ونهضة العقل إلى تكامل أبعاده وحيثياته، بل إن ذلك كله في سباق متواصل للوصول إلى مستوى الطرح القرآني بما يحتضن من أسس وركائز ثابتة ومتينة في منظومة المعارف والعلوم بكافة فروعها وتشعباتها، وكل ما يلامس بعض حقائقه هي محاولات للكشف عمَّا يبتغيه من معانٍ فريدة في تصورها، وكلما سبر الإنسان غور العلم تبين له مداخل ومفاتيح مستجدة على ما استنتجه من معلومات ومفاهيم، وهذا الشأن لا يتوقف شلال عطائه بأي حال من الأحوال ما بقيت الحياة وتضاعفت حاجة الإنسان، وكلما انتهل من نهره الزاخر كان بحاجة إلى الاستزادة دون أن ينقص منه شيئاً، قال تعالى: ?وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً?. من هذا المنطلق فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين يتحدث عن القرآن فإنه يؤكد على الحاجة الماسة لامتلاك بُعد النظر والمدى الرحب في الاستنباط والاستنتاج للوصول إلى المعاني الخصبة، من خلال قراءة المفردات القرآنية بطريقة تنقيبية متقدمة لاستظهار ما به من كنوز ومآثر ترفد الواقع البشري وتخلصه من أعبائه وأزماته المستعصية، وتستنقذه من التيه والهلاك في حياة الدارين، فيقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «اقرؤوا القرآن واستظهروه، فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن»[25]. -------------------------------------------------------------------------------- [1] النحل 89.[2] الإسراء 9. [3] الأنفال 24.[4] الأعراف 56.[5] الأعراف 157.[6] ميزان الحكمة، ج6، ص452. [7] المصدر، ج6، ص452. [8] المجادلة 11.[9] البقرة 2.[10] فصلت 42.[11] البقرة 164.[12] البقرة 242. [13] العنكبوت 35. [14] الحجرات 13. [15] يونس 19. [16] الشيرازي، آية الله السيد محمد الحسيني، الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام، ص75. [17] المصدر، ص75.[18] يونس 99. [19] الرعد 29. [20] الكهف 30. [21] الأنبياء 107. [22] سبأ 28.[23] المائدة 8.[24] الأعراف 157. [25] ميزان الحكمة، ج8، ص78.


 العتبة العلوية المقدسة
العتبة العلوية المقدسة العتبة الحسينية المقدسة
العتبة الحسينية المقدسة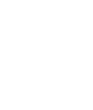 العتبة العباسية المقدسة
العتبة العباسية المقدسة العتبة الرضوية المقدسة
العتبة الرضوية المقدسة العتبة العسكرية المقدسة
العتبة العسكرية المقدسة