السلم في القرآن الكريم

م.م أحمد راضي جبر
من المعاني للجذر اللغوي ( س ل م ) البراءةُ من المرض والبلاء ، ولذلك تخاطب المريض بقولك : الحمد على السلامة ، واستصحبوا هذا المعنى ليطلقوه على الملدوغ فقالوا : سليم ، لمعنيين ، الأول : التفاؤل وبعث السرور في قلب المبتلى ، والآخر : الابتعاد عن وصفه باللديغ تطيُّراً من هذه المفردة ([1]) .
والمعنى الآخر : السلامة ، أي ضد الأذى ، وذهب بعض المعجميين إلى أن تركيب ( السلام عليكم ) بمعنى : الله فوقكم ، لأن السلام من أسماء الله تعالى ([2]) . وهو معنى بعيد ، لأنه وإن كان ( السلام ) من الأسماء الحسنى ، إلا إن المتكلم لا يقصد هذا المعنى وإنما يريد الدعاء بالسلامة للمخاطب ، وهناك دلالات عدة لهذا الجذر اللغوي ، وإنما اقتصرنا على هذين المعنيين لأنهما من صلب مقالتي .
ومعنى السلم ، يكاد يكون طاغيا على الشريعة المحمدية الحنيف حتى لقد سُمِّيت بــ( الإسلام) من باب تسمية الجزء باسم الكل ، وأود في مقالتي هذه أن أوضح عناية القرآن الكريم بالسلم والسلام في حياة المسلم ، وتنوعت الآيات الكريمة في توظيف دلالة ( السلم ) حتى يكون صفة عامة لكل المسلمين . لننعمَ بالراحة والسعادة في الدارين ، إن اتبعنا الطرق التي رسمها القرآن للوصول إلى تلك المعاني السامية ، وهو بخلاف واقعنا المعاش ، فلا داعي لوصف حالة المسلمين في شتى بقاع المعمورة من تشتت وضياع وتشرذم ، حتى تغيَّر شعار الإسلام من السلم والمحبة و( ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) إلى القتل والذبح وكل ذلك سببه الابتعاد عن الشريعة السمحاء ، وأخذ الشريعة من غير معينها الثرِّ .
وابتعاد المسلمين بصورة عامة عمَّن نزل القرآن الكريم في بيوتهم وهم ترجمانه الحق ، السبب الأساس في الأخذ بروايات تفوح رائحة العنف والدماء منها وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا عن الكتاب الكريم ووصفه لرسول الأكرم بأنه ( رحمة للعالمين ) .
هذه من جملة الأسباب التي دعتني إلى إبراز الجانب السلمي في القرآن الكريم ، ولستُ أدعي أني جئت بجديد ، وإنما الحمية على الدين الحنيف لمَّا شوَّه صورته بعض المحسوبين عليه ، رأيت من الواجب على كل مسلم أن يبين للإنسانية عامة أن الإسلام دين محبة وسلام، معتمدا على ما جاء في القران الكريم من هذه المعاني .
فالكتاب الكريم اعتنى ببناء المسلم سلميا ، فنراه يهتم بعلاقته بنفسه أولا ، ومن ثمَ علاقته بالمجتمع ، وأخيرا علاقته بالخالق جل وعز .
السلام النفسي :
فمن الآيات التي أخذت على عاتقها بناء نفس المسلم إنسانياً ، قوله تعالى : (( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب )) ، فمن مصادر الاستقرار النفسي ، والشعور بالراحة والسكون ثبوت الإيمان بالحق تبارك وتعالى في الفؤاد ، فإذا آمن العبد بالله وتذكر نعمه عليه التي لا تعد ولا تحصى فعندئذٍ (( تسكن القلوب وتستأنس وتطمئن إلى ما وعد الله به من الثواب والنعيم، ومن لم يكن مؤمنا عارفا لا يسكن قلبه إلى ذلك )) ([3]) ، وتقابل هذا المعنى آيةٌ أخرى وهي : (( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون )) ، فكيف الجمع بين الآيتين الكريمتين ، وهما تفصحان عن الحالة النفسية للمؤمن إذا ذكر الله تبارك وتعالى ، وهما – كما هو واضح – معنيان متضادان ، الطمأنينة والاستقرار من جهة والوجل والخوف من جهة أخرى ، وللجمع بين هذين المعنيين أن الفرد إذا ذكر فضل الله ونعمه على العبد فعند ذلك يستشعر بحالة من السعادة والطمأنينة تدفعه إلى شكر المنعِم تعالى على تفضله ونعمه بأنْ يُكثر من عمل الخير ، ويبتعد عن السيئات قدر ما يستطيع ، وأما الآية الأخرى فترتبط بحالة العبد إذا ذكر ما أعدَّه الله تعالى للعاصين والمعتدين من العذاب والغضب الإلهي ، فإذا ذكرت الله وأنا قد أذنبت ذنباً أو أسأت تذكر جزاء هذه الذنوب التي سأدفعها في يومٍ من الأيام .
فإذن هناك مقامات للفرد المؤمن يكتسبها شيئا فشيئا بحسب درجة إيمانه (( فإن الوجل المذكور فيه حالة قلبية متقدمة على الاطمئنان المذكور في الآية ... و ذلك أن النعمة هي النازلة من عنده سبحانه ، و أما النقمة أيا ما كانت فهي بالحقيقة إمساك منه عن إفاضة النعمة و إنزال الرحمة )) ([4]) . فإنَّ الخوف أو الخشية إنما تنشأ إذا فكّر العبد بعواقب الأعمال السيئة التي عملها ، فيخاف أن يعاقب عليها ، فإذا علمَ أن الله تبارك وتعالى قد فتح لعباده باباً للخلاص من تلك الذنوب وهو التوبة ، هرع إلى طرق تلك الباب ، والحق تعالى لا يردُّ سائلاً ولا يخيب داعياً ، فإذا استقر هذا المعنى في نفس العبد اطمأنَّ باللجوء إلى خالقه ورازقه . فإن النفس المؤمنة مستقرة وسعيدة (( لاطمئنانها بالوعود الإلهية من جهة، ولاطمئنانها لما اختارت من طريق ، وهي مطمئنة في الدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرت، ومطمئنة عند أهوال حوادث يوم القيامة الرهيبة أيضا )) ([5]) .
وهذا الخوف أو الراحة النفسية والاطمئنان غايتهما واحدة هي تكامل الإنسان أخلاقياً وتنظيفه من الدرن المعنوي قبل المادي سواءً أ كان تحقيق هذه الغاية بالترهيب أو الترغيب .
ومن الآيات الكريمة التي تبين دور نعم الله تعالى في جعل الإنسان مستقرا نفسيا ، قوله تعالى : (( ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَآئفَةً مِّنكُمْ وطائفة قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيّةِ )) ( آل عمران / من الآية 154 ) .
نزلت هذه الآية المباركة بعد معركة أحد التي انكسر فيها المسلمون ، وجرى ما جرى عليهم بمخالفتهم أوامر النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) والقصة معروفة ، فنزلت هذه الآية المباركة تريح نفوس المؤمنين وتُشعرهم بالأمن بعد يومٍ عصيب كاد – لو لا فضل الله - يأتي على الإسلام ، فكان المسلمون بعد انقضاء المعركة شطرين ، شطراً مؤمناً متبعاً لله تعالى ولرسوله الكريم ، وشطراً يظنون بالله ظنَّ السوء بأن المشركين سيعود الكرة عليهم ليقضوا على الإسلام برمته ، متناسين وعد الله تعالى بأنه سيظهر الدين الإسلامي على الدين كله ، فنام المؤمنون مطمئنين بوعد الله ، وبقي المنافقين والمشككين في حالة هلع وخوف ، بسبب (( توعد المشركين لهم بالرجوع، فكانوا تحت الجحف متهيئين للقتال فأنزل الله تعالى الأمنة على المؤمنين، فناموا دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفار عليهم أو يغيروا على المدينة لسوء الظن، فطير عنهم النوم )) ([6]) . فالمؤمن مطمئن مرتاح البال ، ليقينه بأن الله حاميهم ولا يخذلهم أبداً ، أما المنافقون والذين لم يستقرَّ الإسلام في نفوسهم فكانوا متخبطين تأخذهم الأهواء والظنون يمين شمال فـــــ (( لم يزرهم النوم ولا حتى النعاس في تلك الليلة خوفاً على نفوسهم، وعلى أرواحهم، وجرياً وراء الوساوس الشيطانية، والمخاوف التي هي من طبيعة ولوازم النفاق وضعف اليقين ووهن الإيمان، فيما ان المؤمنون الصادقون يستريحون في ذلك النعاس اللذيذ، وتلك النومة الطارئة الهانئة، وهذا هو أحد آثار الإيمان وثماره المهمة البارزة ، فإن المؤمن يحظى بالراحة والطمأنينة حتّى في هذه الدنيا، على العكس من غير المؤمنين من الكفار أو المنافقين أو ضعاف الإيمان، فإنهم محرومون من الطمأنينة والراحة اللذيذة تلك )) ([7]).
وهذا النص يوضح بصورة جلية الحالة النفسية للمؤمن والمنافق ، فالراحة النفسية تزداد كلما اقترب المرء من خالقه والعكس صحيح .
السلام المجتمعي :
ومن النصوص القرآنية التي تبني العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع على أساس الحب والود ، ليسود السلام بين الخلق ، فنرى القرآن يؤكد على مفردة ( السلام ) فأول ما يبتدئ به المسلم كلامه بالتحية ، وجعلها ( السلام عليكم ) وهو تركيب يفيد الدعاء أي : يرزقكم الله السلامة . بل إنهم يستعلمون هذا التركيب حتى مع سواهم من الناس ممَّن لا يلتزم التعاليم الإسلامية ، قال تعالى : (( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين )) ( سورة القصص / الآية 55 ) ، وقوله تعالى : (( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً )) ( سورة الفرقان / من الآية 63 ) . فمن صفات المسلمين أنه (( إذا سَفه عليهم الجهال بالسّيئ ، لم يقابلوهم عليه بمثله ، بل يعفون ويصفحون ، ولا يقولون إلا خيرًا )) ([8]) ، فالسلام هو الصفة الغالبة على المسلم في تعامله سواء من أخيه المسلم أم مع أخيه في الإنسانية .
وقال تعالى : (( وَإِذَا جَاءَك الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَبّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ أَنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سوءَا بجَهَالَةٍ ثُمّ تَاب مِن بَعْدِهِ وَأَصلَحَ فَأَنّهُ غَفُورٌ رّحِيم )) ( سورة الأنعام / الآية 54 ) .
فمن النكت المفيدة واللطيفة في قوله ( سلام عليكم ) أنه جاءت نكرةً ، لدلالة النكرة على العموم ، فالله تعالى قد أمر نبيه الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) أن يدعو للمؤمنين جميعا بجنس السلام ، فالله تبارك وتعالى يريد السلام لعباده ، لأنه كتب على نفسه الرحمة لعباده ، فالدين الإسلامي إنما جاء ليُرَقِّي العبد إلى مراتب الكمال ، وما الأوامر الإلهية إلا منظمة لعلاقات العبد مع نفسه أولا ، ومن ثمَّ مع المجتمع المحيط به ، وثالثا علاقته مع الخالق تبارك وتعالى . إن القران الكريم يريد إبراز الجانب الإنساني والخلقي للمسلم في تعاملاته الدينية والدنيوية ، حتى تعم الرحمة والألفة والمحبة بين الخلق .
الجائزة الإلهية يوم القيامة
(( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون )) ( سورة النحل / الآية 32 ) .
يظل السلام ملازماً المسلمين حتى دخولهم الجنة ، والآيات التي تحدثت على ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى : (( وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أنْ سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون )) ( سورة الأعراف / الآية 46 ) . فأصحاب الأعراف يسلمون على أهل الجنة قبل دخولهم إليها بتحية الإسلام التي تبعث على الطمأنينة والسرور ( سلام عليكم ) يمهدون لهم البشرى الإلهية الكبرى ، ألا هي دخول الجنة .
ومنها قوله تعالى : (( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار )) ( سورة الرعد / الآية 24 ) ، فالملائكة تُبَشِّرُ المؤمنين بذكر ( سلام عليكم ) لتهدأ نفوسهم أولاً من شدة ما رأوا من أهوال القيامة ، ومن ثَمَّ يعرضون عليهم الجنة التي هي (( عقبى أعمالهم الصالحة التي داموا عليها في كل باب من أبواب الحياة بالصبر على الطاعة و عن المعصية و عند المصيبة مع الخشية و الخوف )) ([9]) . فالقرآن الكريم حريصٌ على إبراز مكانة ( السلام ) لدى المسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . وغيرها عشرات الآيات التي ترسم لوحةً فنيةً يكاد الذي يقرأها يشاهد الجنة نصب عينيه ، وأهلها – جعلنا الله منهم – يدخلون إليها والملائكة تبشرهم بذلك الفوز العظيم ، وكل هذه البشارات مبدوءة بـــ( سلام عليكم ) لما لهذا اللفظ من دلالة تبعث الهدوء والاستقرار في النفس البشرية ، فإذا آمن المسلم بالنعيم الأبدي يوم القيامة ، فلا غرو أنه لا يحزن في دنياه ولا يهتم لما يكابده من شقاء أو عناء ، لأن الدنيا محل ابتلاء فإذا مسَّه البلاء هرع إلى الخالق تبارك وتعالى فتطمئنُ نفسه لأنه لجأ إلى ركن شديد ، فإذا علمت هذا استقر في ذهنك المشهد المضاد ممَّن لا يؤمن بالله تعالى فتأخذه الأهواء والظنون كلَّ مأخذ وتكاد حقيقة الموت مؤرقة لهؤلاء فيعيش حياته خاليةً من طعم الأمان فيها ، نسأل الله تعالى أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .
( [1] ) ينظر : العين ، مادة ( س ل م ) .
( [2] ) ينظر : المصدر نفسه ، مادة ( س ل م ) .
( [3] ) التبيان في تفسير القرآن 6/244 .
( [4] ) الميزان في تفسير القرآن 11/118 .
( [5] ) تفسير الأمثل 20/198 .
( [6] ) التبيان في تفسير القرآن 3/21 .
( [7] ) تفسير الأمثل 2/737 .
( [8] ) تفسير ابن كثير 6 / 122 .
( [9] ) الميزان في تفسير القرآن 11/184 .


 العتبة العلوية المقدسة
العتبة العلوية المقدسة العتبة الحسينية المقدسة
العتبة الحسينية المقدسة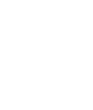 العتبة العباسية المقدسة
العتبة العباسية المقدسة العتبة الرضوية المقدسة
العتبة الرضوية المقدسة العتبة العسكرية المقدسة
العتبة العسكرية المقدسة